“إنّ الحوار الّذي ساد السّنوات السّتّين حول أشكال الإنتاج الماقبل-رأسماليّة كان أشبه منه –بالّنسبة إلى بلدان شمال إفريقيا- إلى تمرين مدرسي مكرّر يتناول مسائل موضويّة من تساؤلات يفرزها واقع تلك البلدان.” [1]
كان يحاول إخفاء الجانب الجزئي والسّطحي لمعارفه بإصراره على تكرار بعض الكتب: البشرة السّوداء والأقنعة البيضاء, الأيدولوجيا الألمانيّة, عروق أمريكا اللاتينية المفتوحة… كانت ثقافته كثقافة راهب قرية, يعوّض فيها ماركس الكتاب المقدّس .
كريستوف روفان, اللّزقة, 2005. [2]
ثانيا: أعدّ بن علي خطّة سرّيّة محكمة لإستئصال الإسلاميّين, مستعينا في صياغة جوانبها النّظريّة والخطابيّة “بصفوة” النّخب اليساريّة والليبراليّة… هذه النّخب الخارجة توّا من أروقة “المركّب الجامعي” -قلعة النّضالات الطّلاّبيّة- ومن بعض مقاهي شارع باريس… هذه النّخب الّتي أعمتها قراءتها الدّينيّة المتطرّفة لمقتطفات من الفكر الماركسي اللّينيني المترجم إلى الفرنسيّة؛ فبرزت للوجود وكأنّها نسخة باهتة ومشوّهة لما ما كان يجري في الحيّ اللاّتيني بالدّائرة الخامسة لبلديّة باريس… هذه النّخب الّتي أعماها حقدها وحنقها تجاه التّيّار الإسلامي الكاسح فأنساها البروليتاريا وأنساها البورجوازيّة الكومبرادور وأنساها الإمبرياليّة, أعلى مراحل الرأسماليّة؛ فباتت ترى نفسها -وهي في أشدّ حالات الهذيان الهستيري- في صراع دامي ونهائي ضدّ بقايا الإقطاع! فالحركة الإسلاميّة في منظورها, حركة ذات مرجعيّة دينيّة تعود إلى “القرون الوسطى”.. إلى مرحلة الإقطاع, لابدّ من محاربتها والقضاء عليها, حتّى وإن لزم الأمر, في سبيل ذلك, التّحالف مع البورجوازيّة, الّتي لا يمكن الوصول إلى تحقيق الثّورة الإشتراكيّة إلاّ في ظلالها! إنّه بحقّ لفولكلور يدعو إلى الضّحك لو لم يخلّف ضحايا وبضع برك من الدّم…
“وطني علّمني, علّمني
أنّ حروف التّاريخ مزوّرة,
حين تكون بدون دماء [3]
شعار رفعه هؤلاء اليساريّون الرّاديكاليّون, ومنذ سنة 1982, عندما أقترفوا ما يسمّى -بحقّ- بمجزرة كلّية الآداب بمنّوبة.
وظنّوا أنّهم فهموا معنى الوطن,
وظنّوا أنّهم فهموا معنى التّاريخ,
وظنّوا أنّهم فهموا معنى الّدم…
وظنّوا أنّهم فهوا مظفّر النّواب, وأنّه كان في صفّهم. لو قرأوا وتريّات هذا الشّاعر, اللّيليّة, وفقهوا معانيها لأيقنوا بأنّ هذا الرّجل لا يمتّ لهم بصلة, لا من قريب ولا من بعيد, ذلك أنّه شاعر ثوري أصيل, لأنّه شاعر لا أكثر…
ثالثا: لقد وصلت إحدى نسخ خطّة الاستئصال الجدّ سريّة بين أيدي القادة الإسلاميين, عندما كانت إحدى مفاخرهم, اختراقهم للسلطة وللحزب الحاكم. ويمكننا تلخيص هذه الخطّة كالآتي: هدف الخطّة النّهائي استئصال الظاهرة الإسلاميّة من الأساس, وذلك “بتجفيف منابعها”… أيّة صورة شاعريّة هذه!؟
تجفيف المنابع هذا يأتي كتتويج لمجموعة من الإجراءات “القانونيّة” المصحوبة بموجة عارمة تستهدف غسلا كاملا للذّهن الجمعي من كلّ “تلوّثات” الفكر والسّياسة والثّقافة والدّين والوعي والحسّ والجمال والتّعبير و.. و.. – فتصبح هذه “التلوّثات” في ذاتها جريمة كما وصفها جورج أوروال في روايته “1984” بعبارة crime de la pensée – بعبارة أوضح : إفراغ الذّهن الجمعي من كل قِوام (consistance). وللقيام بهذه الوظيفة لا يوجد في “السّوق” من هو أجدر ممّن رضع الحليب من بزّ التّجربة السّوفياتية, ومن ترعرع في أحضان ثورة الصّين الثّقافيّة, ومن بلغ سنّ الرّشد في ظلال تجربة الخمير الحمر وتجربة أنور خوجه الألبانيّة…
فبالنّسبة للإجرآت “القانونيّة”, كقانون المساجد الذي حوّل هذه المؤسّسة المستقلّة نسبيّا إلى مجرّد مبنى حكومي تابع لإدارة الشّعائر الدّينيّة الملحقة بوزارة الدّاخليّة… فأصبحت هذه الأخيرة هي الّتي تعيّن الموظّفين فيه من الإمام الخطيب إلى الوقّاد مرورا بالمؤذّن وإمام الخمس, وهي الّتي تملي على هؤلاء الأئمّة الخطب الجمعيّة وغيرها من المواعذ والدّروس الإرشاديّة, بفواصلها ونقاطها… ومن يدري فربما أملت عليهم أيضا ما يجب تلاوته أثناء الصّلاة من السّور والآيات القرآنيّة “وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينْ…” وبذلك أضحى المسجد أفضل مكان لقضاء قيلولة مريحة لو لم يتحوّل -والعياذ بالله- إلى وكر خطير يعجّ بكلّ أصناف المخبرين.. الدّاخل إليه, ممّن يقلّ عمره عن سنّ التّقاعد, مشبوه مدان حتّى تثبت براءته بالإقلاع والتّخلّي عن هذه العادة السيّئة… وياحبّذا لو أرتاد بعض الحانات وذلك درءا منه للشبهات, فيحصل عندها على عُذريّة مواطن العهد الجديد, الصالح.
ثمّ يأتي قانون الزيّ الطّائفي والمقصود به الحجاب, وهو قانون يعود إلى العهد القديم, عهد بورقيبة (سبتمبر 1981), وقع ردّ الإعتبار إليه -أعني القانون طبعا!- فنُفّذ بصرامة وصلت إلى حدّ نزعه بالقوّة على قارعة الطّريق… (القوّة تعني لدى الشّرطي التّونسي العنف الجسدي والإستعمال الغير محدود لألفاظ نابعة من قاموسيْ “ما تحت السّرّة” و”الرّبربة” وهي سبّ الجلالة الإلاهيّة والعياذ بالله) فالحجاب من منظور النّظام هو التّعبير المادي الملموس لأفكار الإسلاميّين. وهو أيضا نقيض توجه السلطة, والنّخب المتعاونة معها, الحداثي. وهو أخيرا مظهرا مشينا لتدنّي كرامة المرأة تحت وطأة وتسلّط المجتمع الأبوي السّائر حتما إلى الزّوال ؛ فكان لابدّ من حجبه عن الأعين.
وأخيرا يأتي قانون الأحزاب الّذي بورك من الجميع -بما فيهم القيادات الإسلاميّة- وذلك أثناء “شهر العسل” السالف الذّكر. وهذا القانون يمنع من التّواجد العلني كلّ حزب يملك مرجعيّة دينيّة أو عرقيّة (الواضح أنّ المقصود بالمنع التيّارات الإسلاميّة والقوميّة العربيّة). وبهذا يصبح حزب السلطات الثلاثة الحاكم, والخاضع لسلطان الرجل الواحد.. يصبح هذا الحزب في نفس الوقت الخصم والحكم في أمر من سواه من التيّارات والأحزاب, مهما عظم شأن بعضهم. وبهذا أيضا, يغدو تشكيل أيّ تنظيم يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة, جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة “الإنتماء إلى جمعيّة غير معترف بها, تستهدف الإطاحة بنظام الحكم وتقف وراءها جهات أجنبيّة”, ويصبح مجرّد منشور منها بمثابة “الثلب والمسّ من كرامة رئيس الدّولة وترويج أخبار زائفة”… ولا طائل من التّذكير بالأحكام الصّادرة في مثل هذه الحالات وما يسبقها من تعذيب وما يتبعها من تشريد وتجويع وترويع لعائلات بأسرها…
ولا بدّ من التّذكير بقانون آخر, كدت أنساه من شدّة تعوّدنا عليه؛ إذ لم يفتأ هذا القانون ساري المفعول, كالسّيف المسلول, رغم تواتر العهود وتدافق الآباء والجدود. فلقد أفرز قانون الصحافة منشورات متشابهة في رداءتها, متوافقة رغم أختلاف عناوينها,لافرق بين صباحها وشروقها, ولا بلاغة في بيانها, ولا شغب ولا إضرابات في شعبها, ولا ماهية لحريّتها, ولو لم أخشى على قارئي من الضجرْ, لسردت من مثل هذا قائمة لا يرى نهايتها البصرْ . والخلاصة أنّ هذه المنشورات ومحتوياتها لا تصلح حتّى كورق مراحيض؛ فلجسد الإنسان حدّ أدنى من الحرمة لا يقبل التدنيس. وللتّذكير أقول أنّ آخر المنشورات الصحفيّة للتيّار الإسلامي, قبل المنع النّهائي, يعود إلى مطلع الثّمانينات… أي ما يناهز الربع قرن!
“الخرق حينما يكون مطلوبا يصبح بدوره إذعانا”. [4]
هذا الجانب “القانوني” من الخطّة… أماّ جانبها “الثّقافي”, فإنّه كان يستهدف “تجفيف منابع الظاهرة الدّينيّة”, ومنابع الوعي, وأيّ شكل من أشكال الخروج عن القطيع بصفة أعمّ؛ وهذا هدف يسري على المدى الطّويل, أُنيط بعهدة “ديمقراطيّينا” السّهر على إنجازه تحت “سامي إشراف سيادة رئيس الدّولة”. فكانت “نوبة”, وكانت “حضرة”, وكانت السينما النّوربوزيديّة وما شابهها, الّتي تداخلت فيها عقد البورجوازيّة الصّغرى -الحقيقيّة- لثلّة من المخرجين بما حسبوه عقدا للشّعب, لتفرز “بزناس” و”عصفور سطح”, “ريح السدّ” و”بنت فاميليا”, فأصبحت محاولات البسيكاناليز الجماعيّة مهرجانا “للعهر والدّروشة”, لا أدلّ عليه إلاّ طوابير الجنود من قوّاتنا المسلّحة أمام قاعات السّينما. وأنوء بنفسي أن أكون من دعات تسليط الرقابة على الإبداعات الفنّيّة, حتّى لا أُفهم خطأً. ولكن ما قيمة الإبداعات الفنّيّة حين تنشأ في ظلّ سلطة قمعيّة تحرصها وتدعمها وتسعى إلى نشرها وتتباهى بها كثمرة لسياساتها؟ ما قيمة العمل الفنّي -مهما كان طلائعيّا وتقدّميّا ورائقا في أعين الأنتليجنسيا الفرنسيّة!- حين يتحوّل إلى بوق دعاية لنظام بوليسي, ولرجل طاغية؟ لاشيء… بل يصبح مشاركة في الجريمة… يعاقب عليها التّاريخ… فلو نظرنا إلى الإنتاج السينيمائي التونسي خلال “العهد الجديد” لخرجنا بالإستنتاجات التّالية:
 تحسّن ملحوظ في الجوانب التّقنيّة تنمّ على ما صارت تنعم به هذه السينما من إمكانيّات نتيجة دعم السلطة لها وكذلك نتيجة العمل بالاشتراك مع شركات إنتاج أوروبية لاسيّما الفرنسيّة منها. والمثل التونسي الشعبي يقول “لا يوجد قطّ يصطاد لله في سبيل الله – أي مجانا-“!
تحسّن ملحوظ في الجوانب التّقنيّة تنمّ على ما صارت تنعم به هذه السينما من إمكانيّات نتيجة دعم السلطة لها وكذلك نتيجة العمل بالاشتراك مع شركات إنتاج أوروبية لاسيّما الفرنسيّة منها. والمثل التونسي الشعبي يقول “لا يوجد قطّ يصطاد لله في سبيل الله – أي مجانا-“!
 تركيز هذه السينما على موضوعات محدّدة, بشكل يدعو للحيرة والتّساؤل : هل زالت كلّ مشكال المجتمع التونسي ولم تبقى إلاّ المسألة الجنسيّة مستعصية عن الحلّ لتهتمّ بها هذه السينما كلّ هذا الإهتمام؟
تركيز هذه السينما على موضوعات محدّدة, بشكل يدعو للحيرة والتّساؤل : هل زالت كلّ مشكال المجتمع التونسي ولم تبقى إلاّ المسألة الجنسيّة مستعصية عن الحلّ لتهتمّ بها هذه السينما كلّ هذا الإهتمام؟
لا ينكر أحد أنّ الجنس معضلة في مجتمعاتنا… وفي كلّ المجتمعات المحكومة بعدميّة ما بعد الحداثة nihilisme post-moderne؛ ولكن أؤكّد لكم أنّه من الصعب جدّا -من النّاحية السيكولوجيّة والبيولوجيّة- حدوث إستنهاض ما ونحن في مؤسسة الرعب والحزن بين مخالب البوليس السيّاسي… من رابع المستحيلات تخيل جسد أمراة مغري والجوع ينهشك نهشا… ومن المستحيل كذلك أن تُبلغ زوجتك أقصى درجات اللّذة orgasme فتعتبرك رجلا وسيّدا للرّجال وأنت تجرّ عصاة الذلّ والمهانة صباحا مساءا.. ذلّ أمام العرف وذلّ أمام شرطي المرور, وذلّ أمام صاحب الدّكّان, وذلّ عند شبّاك البريد, وذلّ في المقهى أمام من أعارك ثمن القهوة بالأمس…
من السّهل جدّا عرض بضعة أكداس من اللّحم الأنثوي وعشرات من الأرداف والأَثْدِ الثقال مطلية بالطَّفْلِ, والكلّ معروض على مصطبة “بيت السخون” لحمّام مُظلم…
من السّهل أيضا تصوير أمرأة “لا بْسهْ مِنْ غِيرْ هُدُومْ” تقريبا, تتمنّع على زوجها الذي راودها عن نفسها حينما تمدّدت على فراش الزوجيّة… فهي تعيش أزمة هويّة مذ أرتبطت بعلاقة حميمة بأمرأتين متحررتين: الأولى مطلّقة والثّانية جزائريّة (البعد المغاربي!) هاربة إلى تونس من سكاكين الإسلاميين, قتلة النّساء والمثقّفين الدّيمقراطيّين… إنّه بحقّ نشيد للحرّية…
من السهل كذلك أن يكون أفتتاح الشّريط بمشهد أنطولوجي جدّ معبّر: إمرأتان تخرجان من البحر جنبا إلى جنب, الأولى رشيقة أوروبيّة عارية إلاّ من بيكيني, والثّانية تونسيّة تجرّ في الماء بصعوبة أذيال فستانها الطّويل وحجابها… ثنائيّة الأصالة والتّفتّح.. الوافد والموروث…
من السّهل أنّ تتحوّل مدينة كاملة إلى أتّون متأجّج بكلّ العقد الجنسيّة : الشباب والأطفال لا مشغل لهم طيلة النّهار وجزء من الليل غير معاكسة الفتيات وأستراق النّظر من ثقوب الأبواب وشقوق الجدران لما يحدث في عالم النّساء المغلق, هذا الفضاء العجيب الغريب ؛ والتّاجر الكهل لاهمّ لديه إلاّ مراودة زبونات جميلات متكسّرات في المشية والكلام, فإن لم ترتدن محلّه تصفّح عندها ما كان يخفيه على أحد الرفوف من المنشورات الجنسيّة ؛ وربّة البيت المحترمة تجتمع في حلقة مع جاراتها ولا حديث لهنّ ولامزاح إلاّ وكان موضوعه وبيت قصيده الجنس, فتتحوّل قفّة الخضر وما برز منها من “فقّوس” (خيار) و”قرع ” وجزر وبطّيخ, إلى منبع إيحاءات إيروتيكيّة الكلّ وسط ضجّة من الضحك والغمز والهمز ؛ وترى الإسكافي, وقد لعبت عليه الدّوخة بعد بضعة كؤوس من” البوخة”, حوّل دكّانه الصغير إلى مخدع يستقبل فيه زبونات تأتينه جاهزات في روبِِ داخلي تحت السفساري, فيغلّق عليهنّ الأبواب, لتتصاعد الآهات والقهقهات…
هل وطن هذا؟ أم مبغى؟ [5]
لماذا لا ينتج هؤلاء الفنّانون بعض الأفلام البوليسيّة, في بلد أضحى فيه البوليس ينافس الأوكسيجين؟ لماذا لا ينتج هؤلاء شريطا واحدا عن “المافيا” في بلد أصبحت فيه الجريمة ركيزة آساسيّة من ركائز الإقتصاد “الوطني”؟ لماذا لا “يقترف” هؤلاء -وهم دعاة ضرب المحرّمات les tabous- فيلما تدور أحداثه في إحدى فترات تاريخ تونس الممتدّ على مدى ثلاثة ألاف سنة على الأقلّ, والّذي يعجّ بالشّخصيّات والأحداث : علّيسة, حنّبعل, صلامبو,الحروب البونيقيّة, تدمير قرطاج, ماسينيسا, يوغورطة, سان أغسطين, الرومان, الكاهنة, عقبة بن نافع, الفتوحات العربيّة الإسلاميّة, كسيلة, جوهر الصقلّي, الإمام سحنون, بنو هلال وزحفهم وجازيتهم, ابن خلدون, سيدي محرز بن خلف, أبو الحسن الشّاذلي, المهجّرون من الأندلس, العثمانييّن, الحسين بن علي باي, خير الدين باشا, علي بن غذاهم الماجري, العزيزة عثمانة, الإحتلال الفرنسي, الزواتنة, عبد العزيز الثّعالبي, محمد علي الحامّي, أبو القاسم الشّابي, خميّس الترنان, محمد الطّاهر بن عاشور, المنصف باي, الدّغباجي, فرحات حشّاد, صالح بن يوسف, علي شورِّب, عتّوقة… آن لكم أن تقرأوا التّايخ قبل أن تقرّروا بجرّة قلم رميه في سلّة المهملات أمتثالا لشيوخكم في الفكر, هناك في زوايا الحي اللاتيني… آن لكم أن تعلموا بأنّ تونس ليست كما أنتم من مواليد الخمسينات… لماذا لا ينتج هؤلاء المبدعون شريطا هزليّا واحدا, أو شريطا من أفلام الخيال العلمي, او حتّى واستارن كسكسي (مقارنة بالواسترن السباقيتي)… حتّى نبتعد شيئا ما عن أجواء العقد النّفسيّة وثنائيّة المرأة/الجنس…
[1] C. LIAUZU “Enjeux urbains au Maghreb, crises, pouvoirs, et mouvements sociaux”, L’Harmattan, 1985, p. 25.
[2] Jean-Christophe Rufin, La Salamandre, Gallimard, 2005.
[3] مظفّر النّواب, وتريّات ليليّة.
[4] Jean-Christophe Rufin, La Salamandre, Gallimard, 2005.
[5] مظفّر النّواب.

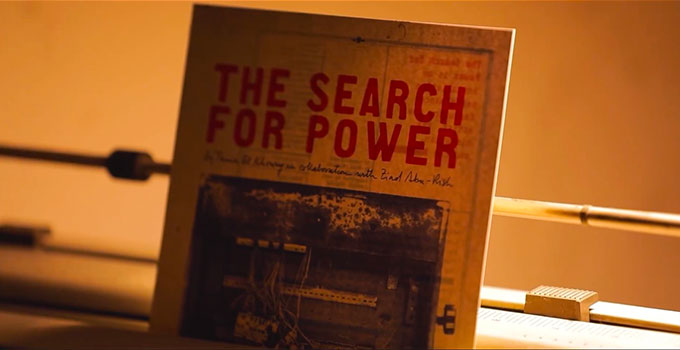
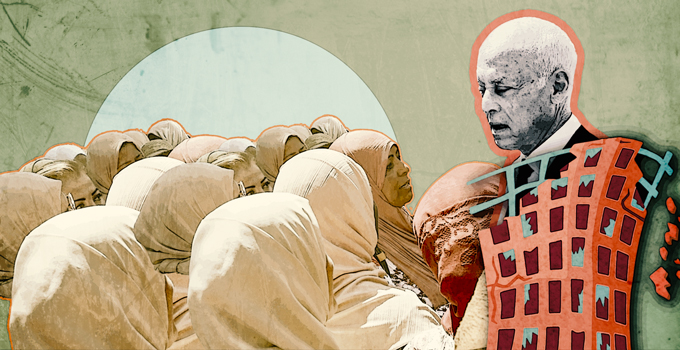
 This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
وأراد ميخائيل ساكاشفيلي أن يقدم خدماته وينجوا برأسه
غريب أمر الرئيس الجو رجي ميخائيل ساكاشفيلي, وهو يتحامق ويتغابى كسيده قاطن البيت الأبيض.
يتحرش بروسيا, ويعمل جاهدا لتخريب علاقات جورجيا مع جيرانها, ويسعى جاهدا لتبقى دوما بحالة متوترة.
لا يهمنا تاريخ ولادة ساكاشفيلي بتاريخ 26/12/1967م. ولا دراسته وتخرجه وتدربه في نيويورك ليكون محاميا من نيويورك. ولا حصوله على الجنسية الأميركية. ولا وصداقاته الوثيقة بكثير من محافظي وصقور إدارة الرئيس جورج بوش وليبراليها الجدد المتصهينيين. ولا حتى علاقته المميزة مع السمراء الفاتنة غونداليزا حين كانت تشغل منصب مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي. ولا أيضا تفضيله الزواج من الهولندية ساندرا إليزابيث رولوفس عام 1995م على بنات جورجيا. فهذه أمور شخصية به, ولا علاقة لأحد غيره فيها.
إنما ما يهمنا الدجل والنفاق السياسي, والمكر والخداع والسلوك العدواني والإرهاب ونزعة العدوان والإجرام والازدواجية, والذين هم الصفات المشتركة لكافة الليبراليين الجدد المتصهينيين والمحافظين الجدد.والذين منهم ميخائيل ساكاشفيلي. بحيث باتوا كبالونات منفوخة بالكراهية والعدوانية للإنسانية وشعوبهم وكل دين سماوي.
ولو دقق القارئ تصرفات الرئيس ورجل القانون ساكاشفيلي, لوجد أنه ليس سوى إرهابي صهيوني:
1. فساكاشفيلي يعتبر أن الحرب في العراق تمثل خط الدفاع الأول في الحرب على الإرهاب. وشارك بقوات قوامها أكثر من ألفي جندي لتكون الثالثة بعد القوات الأميركية والبريطانية في العراق.
2. ويعلن على الدوام,أنه لن يسمح لإيران أن تحقق مآربها. فإسرائيل هي من تهمه وليس جورجيا.
3. ويعتبر أن ما يصيب أو يلحق بإسرائيل من أذى, يلحق ويصيب جورجيا أيضا. ويقسم الأيامين المغلظة, بأن المكان الوحيد الذي يشعر فيه أنه في وطنه إنما هو دولة إسرائيل.
4. وهو من دخل البرلمان عام 2003م وبيديه وردة تعبيرا عن الثورة الوردية التي صدرتها الادارة الأميركية إلى جورجيا. وكان يردد شعارات السلام والحرية والديمقراطية. ولكنه حين أصبح رئيسا لجورجيا , أستبدل الوردة بالمدفع, والسلام بالحرب,و أستبدل الحرية والديمقراطية بالديكتاتورية.
5. عينه الرئيس أدوا رد شيفارنادزة وزيرا للعدل كونه محاميا, إلا انه سرعان ما انقلب عليه, وفبرك مع الادارة الأمريكية تهمة تزوير شيفارنادزة للانتخابات. وأعيدت الانتخابات بالمعايير والمقاييس الأميركية المفصلة خصيصا على قياس عملائها وليبرالييها.فحصد منها رئاسة جمهورية جورجيا. ومن يوم تقلده لمنصب الرئاسة, وهو يزور الانتخابات والنتائج على مزاجه. وتحول إلى مستبد وطاغية.
6. وثق تحالفاته وعلاقاته بالإدارات الأميركية وإسرائيل. وتطوع ليضع جورجيا في خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وراض ٍ وعن قناعة أن يكون بمثابة مخلب قط لهما.
7. قمع بوحشية المظاهرات المعارضة له عام 2007م, وسحق ثورة القراص الجورجية بوحشية. ومع ذلك يحظى بدعم وتأييد وحب الادارة الأميركية. وترى في نظامه, تجلي الديمقراطية بأبهى صورها.
8. ويسعى لتكون جورجيا عضوا في حلف الأطلسي. وبوش يضغط على ألمانيا وفرنسا في هذا المنحى. ويطالبهم بقبولها في الحلف على جناح السرعة,لربطها بمعاهدات هيمنة و وصاية. ليسرح ويمرح فيها حلف الأطلسي بحرية, قبل أن يسقط الجورجيين ساكاشفيلي , ويهرب إلى المكان الذي منه أتى.
9. وراح يعوض عن فشله السياسي والاقتصادي, وتنكره لما وعد به الجورجيين, بوضعهم في حالة الخوف والقلق والرعب. من خلال تحرشه بجيرانه, واحتلاله بعض مدن أوستينا الجنوبية وأبخازيا. وتوتير الأجواء بين جورجيا وجيرانها بأساليب قذرة, والزج بجورجيا بأتون نار حرب مدمرة.
10. غزا أوستينا الجنوبية وأحتلها,ضاربا بعرض الحائط جميع تمنيات دول العالم وروسيا عليه بأن يدع أوستينا وشانها. وأن لا يندفع خلف أحلامه المريضة, كي لا يعرض المنطقة والأمن الدولي للخطر. وكل ظنه أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ستهرع لمساعدته ودعمه إن حاولت روسيا الإعتراض أو الاحتجاج على احتلاله لأوستينا وأبخازيا. إلا أن الرد الروسي السريع أخذ بهم وبعميلهم ساكاشفيلي على حين غرة . فلم يجد الأوروبيين أمامهم إلا التحرك للوساطة . بينما لجا الرئيس جورج بوش وإدارته, لدعم ومساعدة ساكاشفيلي بالثرثرة والكلام الفارغ والتصريحات الخطابية فقط.
11. و حقد ساكاشفيلي للصين ولشعوب العالم, دفعه ليفسد ليلة أفتتاح أولمبياد بكين, ويتخذ من ليله موعدا لعدوانه.حين قصفت قواته بكثافة ووحشية عاصمة ومدن وقرى أوستينا لساعتين, قبل إعلانه الحرب على أوستينا, واحتلال قواته لعاصمتها تسخينفالي,وقيامها بارتكاب مجازر حرب ضد سكانها العزل.
12. وإعلان ساكاشفيلي الحرب على اوستينا هو إقرار واعتراف منه بأن أوستينا جمهورية مستقلة. وهذا دليل على غباء وجهل هذا الرئيس بكل شيء. وهو رجل القانون الذي لا يجوز أن يرتكب هذه الغلطة.
13. وعدوان ساكاشفيلي على أوستينا, إنما هدف منه مساعدة الرئيس جورج بوش وحزبه الجمهوري, بقطف نصر خاطف يخدمهم في الانتخابات الأمريكية القادمة إن كان لمنصب الرئاسة الأمريكية, أو لعضوية مجلسي الكونغرس. وهذا تدخل فظ منه بالشؤون الداخلية الأمريكية. رغم أنه كحامل الجنسية الأمريكية, وأحد الليبراليين والمحافظين الجدد, يجد لزاما عليه دعم الحزب الجمهوري الذي يميل إليه. وقد ظهر ذلك جليا من خلال دعم جون ماكين لساكاشفيلي اللامحدود وتنديده بروسيا, وطلبه مساعدة ساكاشفيلي على الأقل كونه مواطن أميركي. بينما أنتقد اوباما تصرفه رغم تنديده هو الآخر بروسيا.
14. وساكاشفيلي ظن أنه بعدوانه واحتلاله لبلاد جيرانه سينقذ نظامه من السقوط بالتزامن مع سقوط جورج بوش. فعمد إلى خلط الأوراق بعدوانه عله يخرج كمنتصر وبطل قومي. فخاب وبات سقوطه حتميا
15. وعلى الرغم من تحمل الروس لجنونه وحماقته وشذوذه وتخرصاته, وتعاملهم معه بحكمة وأناة ورزانة وروية وطول صبر وبعد نظر. ولجوء روسيا إلى مجلس الأمن الدولي, بتقديمها شكوى على عدوان ساكاشفيلي على أوستينا وتدميره عاصمتها تسخينفالي. وجريمته بقتل جنود حفظ السلام الروس المنتدبين بقرار من مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الأمن في القوقاز. إلا أن المجلس بضغط وعرقلة من الادارة الأمريكية ومندوبها المرقط بجنسيتيه الأفغانية والأمريكية, لم يوافق على بحث الشكوى, مما أضطرها لاتخاذ قرار بحماية قواتها وأمنها وجيرانها وأوستينا من مجلس أمنها القومي.
16. وروسيا أرادت أن تصفع ساكاشفيلي بقسوة. لترتعد مفاصل إدارة بوش وبعض الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي من هول الصفعة.لأنها تعرف أن ما قام به ساكاشفيلي, إنما بوحي من إدارة الرئيس جورج بوش . وأن من أهدافه أيضا دعم انتخاب المرشح جون ماكين. وكذلك اختبار وجس نبض روسيا لمعرفة ردات فعلها , من ارتماء البعض في حضن الناتو ونصب منظومة الدفاع الصاروخي.
17. وساكاشفيلي وإسرائيل اتفقا على جعل جورجيا معسكر تجمع لعناصر اللوبي الإسرائيلي لتنشيط تواجدهم في منطقة القوقاز.بإعادة بعض من هاجر إلى إسرائيل من تلك المناطق, وتزويدهم بالأموال والقدرات والخبرات . بحيث يؤهلهم للعبور إلى باقي الدول والاستيلاء على مقدراتها والتحكم بقياداتها, لإخضاعها لدائرة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك تم إرسال كبار الضباط, و عناصر من الجيش و المخابرات, وبعض كبار رجال الأعمال الصهاينة من اليهود. لتشكيل وتنظيم وتدريب وتسليح فرق للمرتزقة كشركات أمنية في جورجيا. لتكون جورجيا قاعدة متقدمة لإسرائيل في القوقاز ,بحيث يؤهلها التسلل إلى أسيا وأوروبا وإيران وتركيا وجيران جورجيا بيسر وسهولة للتحكم بمواقفهم ومواقف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وروسيا, وتهديد أمن كل من يعارض صهيينة وأمركة العالم. حتى أن ساكاشفيلي عين وزيرين إسرائيليين في حكومته . هما وزير الدفاع دافيد كزراشفيلي الذي عين عام 2006م, ووزير المقاطعات الجنوبية تيمور يعقوبو شيفيلي, إضافة لآلاف المستشارين.
18. ورد روسيا الحاسم على عدوان ساكاشفيلي .دفع بموقف الاتحاد الأوروبي ليأخذ ثلاثة اتجاهات:اتجاه تقوده فرنسا, ويطالب بإنسحاب كل من القوات الجيورجية والروسية إلى مواقعها السابقة قبل العدوان الجورجي. والرئيس الفرنسي ساركوزي أعلن بان هنالك التزاما أوروبيا وروسيا بضمان واحترام سيادة جورجيا. وهذا دحض لما يدعيه ساكاشفيلي. واتجاه تقوده إيطاليا عبر عنه وزير خارجية إيطاليا حين أعلن بان بلاده لن تنضوي في أي تحالف لحماية جورجيا. إضافة إلى أن بلجيكا اعتبرت ساكاشفيلي المسئول عن المعارك نتيجة تدخله العسكري غير المبرر. واتجاه تقوده بريطانيا وبولندا, ويدعو للتدخل لحماية عدوان ساكاشفيلي. وهو ما وضع حلف الناتو بموقف العاجز عن إتخاذ أي قرار.
19. وبعد تصدي روسيا لعدوانه ومعاقبتها لجورجيا. راح كل من الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي والرئيس جورج بوش ونائبه وبعض رموز إدارته يصيحون على أثرها كمخبولين فقدوا عقلوهم , وبات كلامهم ثرثرة بثرثرة يناقض بعضه بعضا, وأشبه بصراخ زعران الحارة. وفيه إدانة لهم ثابتة وواضحة.
20. وكثير من دول الاتحاد الأوروبي وبخت وأنبت ساكاشفيلي , واعتبرته المسئول عن الحرب , وانه هو المعتدي. حتى أن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن الاتحاد الأوروبي هو من تقع عليه مهمة تسويته لأن واشنطن طرفا فيه نوعا ما. ودبلوماسي أوروبي رفيع المستوى وصف تصور ساكاشفيلي بإمكانية استعادة أراضي بالقوة العسكرية الجورجية دليل على أنها حسابات شخص مغفل.
21. وحتى الادارة الأمريكية التي فقدت صوابها بسبب هزيمة ساكاشفيلي, وراحت تهدد وتتوعد وتندد بروسيا, وتهددها بالحصار والمعاقبة.سربت هي الأخرى على صفحات الواشنطن بوست خبرا مفاده :أن السيدة رايس نصحت ساكاشفيلي بالتروي وعدم اللجوء للعدوان أو الحرب على أوسيتيا وأبخازيا.
ولو قارن المرء بين مواقف البعض من الأنظمة والحكومات والأمم المتحدة والإدارة الأميركية الحالية من جورجيا ومواقفهم السابقة من حروب الخليج الثلاث لهاله حجم الازدواجية في المواقف,والكم الهائل في النفاق والمكر والخداع وازدواجية المواقف وتعدد المعايير التي لا تحصى ولا تعد.ومنها على سبيل المثال:
• وهاهو ساكاشفيلي يطالب حلف الأطلسي بوقاحة قائلا: أدعوا حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة إلى وقف العدوان الروسي.رغم أنه هو من اعتدى على أوستينا الجنوبية وأبخازيا ليهدد أمن روسيا.
• ويعتبر شاكاسفيلي أن الرد الروسي على عدوانه, أشبه بهجوم الاتحاد السوفييتي على أفغانستان والذي كان حينها طفلا صغيرا لا يعرف من أمره شيئا. وكأنه يناشد بذلك تنظيم القاعدة ليقدم إليه المساعدة.
• ويتهم قائد حلف الأطلسي روسيا بالاستخدام المفرط للقوة في أوستينا الجنوبية وانتهاك وحدة أراضي جورجيا. متجاهلا بمكر الاستخدام المفرط للقوة الذي ليس له من مثيل من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية في الضفة وقطاع غزة منذ أكثر من أربعين عاما, وعلى العراق منذ عشرون عاما.
• والرئيس جورج بوش يعتبر الرد الروسي غير مقبول, ويعلن وقوفه مع المعتدي ساكاشفيلي.متجاهلا شن أبيه الحرب على العراق عام 1991م لنفس السبب . وأن ما تفعله روسيا لتحرير أوسيتيا وأبخازيا على اعتبارها جارة, هو نفس ما فعله أبيه لتحرير الكويت رغم أن بلاده ليست للكويت والعراق بجار.
• والرئيس جورج بوش والرئيس ساركوزي والمستشارة ميركل اتفقوا بسرعة على ضرورة وقف إطلاق نار غير مشروط, وعلى ضرورة احترام الأراضي الجورجية, ودون أن يشيروا إلى ضرورة أنسحاب القوات الجورجية المعتدية. بينما لم نجد لهذا الموقف من أثر أثناء الحرب العراقية الإيرانية, أو حين أحتل العراق الكويت, أو حين غزا و أحتل الرئيس جورج بوش العراق. حين لم تسارع دولهم للدعوة لإيقاف نار غير مشروط ,واحترام أراضي هذه الدول .وإنما سارعوا لتحميل العراق كامل المسئولية, وفرض جميع العقوبات بحقه وبكل أصنافها. وكذلك لم نجد لهذا الموقف من أثر حين اعتدى بوش على العراق بذرائع كاذبة عام 2003م. رغم أن التدخل الروسي ضروري وشرعي ومبرر,لأنه تنفيذ لمعاهدة تحالف مع دول الاتحاد السوفييتي السابق, بينما غزو العراق غير شرعي.
• وقوف الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مع المعتدي والجاني والإرهابي ساكاشفيلي, وإدانتهم لروسيا وأوسيتيا وأبخازيا رغم أنهم الضحية والمحنى عليهم. وبنفس الأسلوب والموقف الذي يقفونه مع الجاني الإسرائيلي والأميركي ضد الضحايا من الشعب العربي في فلسطين ولبنان والعراق.
• وروسيا لم تتدخل إلا دفاعا عن النفس وعن المواطنين الروس في أستونيا, بعد أن قتل ساكاشفيلي أكثر من 2000جندي روسي من جنود قوة السلام الدولية ودمر عاصمة أوستينا وقراها حيث قتل الألوف من مواطنيها. في حين أعلن جورج w بوش الحرب على العالم بسبب مقتل أقل من هذا العدد بكثير في هجوم تنظيم القاعدة على برجين في نيويورك بتاريخ 11/9/20001م, ومازالت هذه الحرب مستعرة.
• وحرب ساكاشفيلي على أوستينا كانت حرب إبادة عرقية, ومع ذلك لم تحرك الشرعية الدولية ساكنا. بينما هي توصف بعض الحروب والصراعات على أنها حروب إبادة رغم أنها ليست بحروب إبادة لتحشر أنفها في التدخل بهذه النزاعات لمآرب وغايات وأهداف أخرى ولصالح الادارة الأمريكية.
• وحماية روسيا لمواطنيها الروس في أبخاريا وأوسيتا حق مشروع. بينما تسعى الولايات المتحدة لتمزيق العراق والسودان ودول أخرى إلى دويلات طائفية وعرقية لا علاقة أو روابط بينها وبين أمريكا. والمضحك أنهم يرفضون أن تكون أوسيتيا وأبخازيا كيانات مستقلة ,بينما يدعمون كردستان العراق ودارفور وجنوب السودان لكي تكون كيانات مستقلة أخرى.
وهذا الموقف الأمريكي والإسرائيلي المتناغم رغم تناقضه في مواضع أخرى, يلتقي مع أهدافهما المشترك في:
1. تشجيع روح الانفصال ومنطق التجزئة والتشرذم في دول العالم ليسهل أمركة هذه الدول.
2. تنمية ورعاية الخلافات والمشاكل بين كل دولة وجيرانها, لمنع تحقيق الوحدة أو الاتحاد, أو حتى التعاون والبناء والعيش المشترك, بحيث تبقى الدول ضعيفة وواهنة , ورهينة أوضاعها الداخلية وعلاقاتها المتوترة مع جيرانها. بحيث يسهل على الادارة الأمريكية توقيع معاهدات لفرض الهيمنة عليها, وجعل أراضيها قواعد للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلسي.
3. السيطرة على مناطق النفط وطرق إمداداته , ليسهل التحكم بقيادة أوروبا والعالم.
4. واحتلال ساكاشفيلي لأوستينا تم بضوء أخضر أمريكي , وبتنسيق أمريكي إسرائيلي. فهما من درب وحدات الجيش الجورجي في جورجيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأمدوه بالعتاد الحربي المتطور وبشركات أمنية ومرتزقة متطورة. وتم التغطية على توقيته بإعلان كل من الادارة الأمريكية وجورجيا إجراء مناورات عسكرية مشتركة في نفس اليوم الذي اختير للعدوان على أوستينا وذلك بهدف أستفزاز روسيا, واختبار إمكانية الرد الروسي,قبل توظيف الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي في دعم عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران..إلا إن النتيجة كانت كارثية على كل من إدارة جورج بوش وإسرائيل. حيث تبين:
• أن الشرخ بات عميقا بين ساسة إسرائيليون لا يريدون زج إسرائيل بأتون حرب مدمرة مع إيران أو نزاعات مع روسيا. وبين جنرالات إسرائيل كباراك وزير الدفاع ونتنياهوا وموفاز وغيرهم الذين يريدون خوض هذا الصراع وتدمير المنشآت النووية الإيرانية, ودعم ساكاشفيلي خدمة لإدارة بوش ومنظمة إيباك
• وزج إسرائيل بهذا الصراع لم تجني منه سوى عداء روسيا حكومة وشعبا.
• وكذلك فاقم الخلاف بين رموز الادارة الأمريكية. ففي الوقت الذي رفع الرئيس بوش ونائبه تشيني ورايس من أصواتهم بالويل والثبور وعظائم الأمور تجاه روسيا, واستنكار تصرفها وعدوانها على جورجيا. أعلن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية. أن جورجيا تتحمل جزء من المسئولية عن هذا النزاع. وأكد المسئول المذكور, أنه خلال كل هذه المرحلة دعونا بقوة الحكومة الجورجية إلى أن تظهر ضبط النفس, وتتفادى بأي ثمن نزاعا وتصعيدا عسكريا مع روسيا, وكنا واضحين جدا.و أوضحنا للروس أنه في حال إستمرار التصعيد غير المتكافئ والخطير من الجانب الروسي,فإن ذلك سيترك أثرا كبيرا على المدى الطويل على العلاقات الروسية الأميركية.
• وإسرائيل أرادت أن تحرر يد إدارة الرئيس جورج بوش لتتمكن من التدخل في جورجيا ليكون مقدمة وتشجيعا لتدخلها ضد إيران .فحسم وزير الدفاع الأميركي وقيادة الأركان الموقف بأنهم لن يتورطوا بنزاع جديد وإضافي مع روسيا.
• وكاد يما والليكود أرادوا فك طوق الحصار والعزلة عن إيباك وبعض منظمات اللوبي الصهيوني ,بعد أن باتوا لا قيمة ولا وزن لهم في الانتخابات القادمة. فخابوا. وعمقوا جذور الأزمة فيما بينهم وبين المجتمعين الأمريكي والأوروبي.
مهما حاولت وسائل الإعلام المشبوهة ,أو الممولة من الادارة الأمريكية أو إسرائيل والصهيونية, أو من حلفاء الادارة الأمريكية, طمس الصورة , وتزييف الحقائق , وقلب المفاهيم, وعرضها بصور معكوسة. إلا أن العدوان الأمريكي الذي قاده المتأمرك والليبرالي الجديد وأحد صقور المحافظين ساكاشقيلي من جورجيا ضد جيرانه وروسيا. يمكن قراءة نتائجه على هذه الصورة, ووفق المنطق التالي الذي يجانب الحق والحقيقة:
• هزم ساكاشفيلي هزيمة منكرة. لأنه ظن أن مصالح الادارة الأمريكية التي يدافع عنها ,ستدفع بالإدارة الأمريكية ودول حلف الناتو الأوروبية إلى التدخل لدعم عدوانه, وخاصة أن السياسة الرائجة حاليا هي سياسة المصالح الخاصة. ناهيك عن طلبه الانضمام لحلف الناتو, ومحاولاته إضعاف وتمزيق روسيا.
• وغباء وحماقة جهل ساكاشفيلي أعمت بصره وبصيرته عن جملة من المصالح للدول:
1. فأوروبا بحاجة ماسة إلى الطاقة الروسية والغاز الروسي, ولن تقامر بمصالحها الاقتصادية.
2. والولايات المتحدة الأمريكية التي عادت مجبرة لمظلة الأمم المتحدة نتيجة هزائمها المنكرة, والتزامها بتقرير بيكر, لتشرعن حربها على الإرهاب واحتلالها العراق وأفغانستان , وتستظل بظل الشرعية , غير قادرة ولن تجرأ على تجاوز الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
3. والإدارة الأميركية ودول أوروبا وإسرائيل بأمس الحاجة لدعم روسيا بمعالجة الملف النووي الإيراني. وما من أحد منهم مستعد أن يعادي روسيا بأكثر من الكلام في هذه المرحلة.
4. وظنون ساكاشفيلي على أنه قوي طالما هو يرتكز على القوة العظم, لم تكن في محلها. فهذه القوة باتت بسبب هزائمها في العراق وفلسطين ولبنا وأفغانستان أشبه بسكين مثلومة.
5. وحماقة ساكاشفيلي الخيرة, جعلت الشعوب الأوروبية وكثير من الحكومات الأوروبية أكثر حذرا من دخول جورجيا حلف الناتو , وعضويتها في الاتحاد الأوروبي , لأن هذا معناه أن أوروبا ستجر من جورجيا أو ساكاشفيلي إلى حالة من الحرب مع الروس, وهذا ما يجتنبونه.
6. وعدوان ساكاشفيلي سيدفع بتركيا وإيران وروسيا لبناء تحالفات تخدم مصالحهم وأمنهم القومي.ودفع بباقي الدول لتتوجس خيفة مما تبيته كل من الادارة الأمريكية وإسرائيل لبلادهم.
• والحرب التي شنها ساكاشفيلي إنما هي تنفيذ لمخطط أمريكي .يهدف تغلغل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خاصرتي وبطن وظهر روسيا في مناطق القوقاز.من أجل إكمال طوق الحصار عليها, ومن ثم خنقها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا.للقضاء على أي دور لها حاضرا أو مستقبلا.
بأختصار شديد: أراد ميخائيل ساكاشفيلي أن يقدم خدماته لأسياده وينجوا برأسه, فهزم وخاب وزاد الطينة بلة.ومن يدري؟ فلربما سيتهم على أنه بعدوانه وهزيمته المنكرة, ساهم في تحطيم أحلام المرشح جون ماكين والجمهوريين والمحافظين الجدد,وانه بتسرعه وحماقته كان السبب في إجهاض دور جديد تسعى إليه إسرائيل!
الاثنين: 18 /8/2008م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
بريد إلكتروني: .burhank45@yahoo.com
.bkburhan@maktoob.com
.bkriem@gmail.com
هل هذه أسباب سقوط زين العابدين بن علي؟
يقول معارضو زين العابدين بن علي عنه:أن أنانيته وازدواجيته وعشقه لذاته,أنسته ربه وشعبه والعالم من حوله.
وأنه يفاخر بنفسه وبحنكته وذكائه ودهائه,بعد أن تمكن من كسب ثقة بعض بطانة الرئيس الحبيب بورقيبة. فقربوه منه,فأحبه الحبيب بورقيبة ووثق به.وأعاده من بولندا التي كان فيها سفيراً لبلاده. وجعل منه أكثر المقربين إليه, حين عينه وزيراً للداخلية. ليكون المسؤول عن أمنه وامن بلاده.وبدهائه تمكن من التخلص منهم واحداً بعد الآخر كي ينفرد ببورقيبة.وبعد أن تحقق له ذلك. سارع بالانقلاب على ولي نعمته وعزله من الرئاسة رغم أنفه. بذريعة قطع الطريق أمام الإسلاميين في تولي السلطة أو المشاركة فيها.وحجره في منزله بانتظار عزرائيل كي يقبض روحه ويرتاح منه.وبعد أن استلم منه كل صلاحياته ومهامه.راح يضيف لنفسه صلاحيات ومهمات جديدة كي يكون الدستور التونسي وكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية رهن إشارته. ولم ينسى أن ينصب ذاته وصياً شرعياً على كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحزبية,كي تأتمر بأوامره وتنفذ توجيهاته وإرشاداته.وراح يعيث فساداً وخراباً في تونس ومحيطها العربي.فعادت تصرفاته هذه وبالاً عليه. فانتفض عليه شعبه معلناً ثورة الياسمين عليه وعلى نظامه والتي انتهت بسقوطه.
يتهمه معارضيه بأنه أشاد نظام قمعي وبوليسي ليكون النموذج التي كانت فرنسا تحلم بقيامه في تونس وغير تونس,بعد إجبارها على الجلاء عن دول المغرب العربي.وأن كل ما قدمه لتونس خلال فترة حكمه إنما هو:
• منع ارتداء الحجاب.وعدم تعيين المحجبات في الدوائر الحكومية.
• منع مكبرات الصوت في المساجد. ومنع الأذان بمكبرات الصوت من على المآذن.
• منع الصلاة في المسجد إلا لمن يحمل البطاقة الممغنطة لاستخدامها في الجهاز علي أبواب المساجد.
• منع تعدد الزوجات. وحظر الزواج من أكثر من واحدة حتى لو لم تستطيع الإنجاب.
• الضغط على دول العالم كي لا تستقبل أي معارض تونسي لسياساته أو لنظامه.
• أغلق مدارس تحفيظ القران في تونس. وألغى تدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس التونسية.
• أمر بحبس أي إنسان يقوم بتطويل لحيته على أساس ديني.
• استغل السلطة لتأمين مستقبل أزواج بناته وأخوته وأصهاره وأقارب زوجته.
• جعل من تونس مثالاً يحتذى به في مواجهة قوى المقاومة الوطنية والحركات الإسلامية.
• كان تلميذاً نجيباً في الاستجابة لشروط صناديق القروض والتمويلات الغربية والأميركية.
• وطد علاقاته مع الحكومات الفرنسية والإدارات الأميركية. وأرسى تعاون وتنسيق كامل بين أجهزته الأمنية والاستخباراتية وبين أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية والفرنسية.وعاهدهم على أن يكون في خدمة مصالحهم ومصالح حلفائهم داخل تونس. وفي كل مكان من العالم.حتى أن وزيرة الخارجية الفرنسية طالبت بدعم أوروبي لنظام بن علي ووضع خبرة فرنسا في المجال الأمني بخدمته.
• وضع معادلة بسيطة تضع المقاربة الأمنية قبل المقاربة الديمقراطية.على اعتبار أن الديمقراطية يمكن لها أن تنتظر إلى ما بعد تحقيق التنمية الاقتصادية.وبهذه المعادلة حاز على رضا دول غربية باتت تعتبره نموذج فريد من حيث قدرته على الجمع بين التنمية والاستقرار وحماية المصالح الغربية والأميركية. بل أن هناك من يتهم بعض رموز نظامه لهم صلات وثيقة مع أجهزة أمن فرنسية أو أمريكية وإسرائيلية.
• حول بنظامه البوليسي تونس إلى أكبر سجن للإسلاميين في الوطن العربي وشمال أفريقيا.
• قضى على حرية الرأي والتعبير,ودجن الصحافة, وقضى على النقابات.وأفقد الأحزاب السياسية التي تعاملت معه كل صدقية داخل الشارع التونسي. حتى أن حزبه بات حالياً مهدد بالتشظي إلى ثلاثة أقسام. قسم مازال مؤيد له, وقد يلجأ إلى السرية للحفاظ على بطانته. والقسم الثاني قد يتجه صوب الحركات الإسلامية. والقسم الثالث سيلتحق حتماً بقوى القومية العربية.
• ساهم في بروز طبقة برجوازية انتهازية. قوامها أفراد أسرته وأسرة زوجته(أسرة بن علي مؤلفة من ستة أشقاء وشقيقات وأزواج بناته الثلاث من زواجه الأول .وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي مؤلفة من عشرة أشقاء وشقيقات وعدد كبير جداً من الأولاد).وأصبحت هذه الطبقة تتحكم بمقدرات الشعب التونسي في ميادين الاقتصاد والإعلام والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة وعالم المال والأعمال والفن والرياضة. بحيث أطبقت بأيديها خلال السنتين الماضيتين على ما يعادل 40% من اقتصاد الدولة التونسية. وقد بدأت تتكشف الكثير من الأمور على فسادها.وخاصة بعد أن تبين:
1. سيطرة بلحسن طرابلسي على شركة قرطاج الجوية وشركة طيران, وشركة هواتف غلوبال نت ورركينغ,ووكالة شاحنات فورد وجاغوار وهونداي,إضافة إلى فنادق وقرى سياحية. والقناة التلفزيونية قرطاج تي في وإذاعة موزاييك .وشراء أراضي شاسعة مقابل يورو واحد رغم أنها مصنفة من قبل الأونيسكو على أنها تراث عالمي,وبيعها بمبالغ خيالية.وبنا علاقة اقتصادية قوية مع إمارة دبي وبعض رجال المال والإعمال في دول النفط,حيث حصل على عمولة بلغت 50مليار دولار مقابل بيع 35%من شركة هات تونس إلى مجموعة إماراتية.
2. إجبار سليم شيبوب (وهو زوج ابنة بن علي)الحكومة التونسية على تغيير وتعديل القوانين التونسية.بما تسمح له بفتح فرعاً لسلسلة سوبر ماركت كارفور الفرنسية.إضافة إلى وضعه اليد على سوق الدواء وعلى أراضي زراعية شاسعة اشتراها بسعر زهيد جداً جداً. علما بأن سليم شيبوب هو رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي,وهو نادي العاصمة الكبير.
3. تسخير أسرتي بن علي والطرابلسي أجهزة الأمن ومصلحة الضرائب, لإجبار ملاك شركات مربحة وناجحة, بالتخلي عن شركاتهم لصالح أفراد من الأسرتين لقاء مبالغ زهيدة.
4. تخصص صخر الماطري زوج سرين الابنة البكر لبن علي وليلى الطرابلسي في التمويل الإسلامي.وفرضه الخوات على عطاءات الدولة وغيرها من الميادين الاقتصادية.
5. أستغلال ليلى الطرابلسي حب زوجها لأبنها الصغير محمد بن علي البالغ من العمر 6 أعوام.وذلك من خلالها تهديدها له بإبعاده عنه لتحقيق مآربها الدنيئة.وخاصة عندما هربت به إلى دبي.ولم تعد إلى تونس إلا بعد أن خصخص تجارة الشاي والبن لمصلحة أحد أشقائها.
6. حقق بن علي ثروة لنفسه تقدر بستة مليارات ,بينما حققت ليلى الطرابلسي لها ولعائلتها ثروة تقدر ب14 مليار دولار.
• أسهم بفعالية في تهميش الشعب التونسي وتفاقم الفقر,وتنامي البطالة إلى 25% في المجتمع التونسي.
• في ظل حكمه تمكنت إسرائيل من اختراق أمن بلاده وذلك باغتيالها لقادة فلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح إثناء إقامتهم في تونس. وكذلك إرسال جنودها خلال عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006م لقضاء فترة استراحة ونقاهة إلى تونس, قبل أن يعودوا للقتال في جنوب لبنان. وكان حرسهم الأساسي من أمن القوات اللبنانية لأنهم كانوا لا يثقون بالأمن التونسي.
• حظي نظامه بدعم وتأييد من ساركوزي الذي كان يعتبره نموذج فرنسي.وكان ساركوزي يرفض المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس,ويشيد بجهود بن علي في محاربة الإرهاب. باعتبارها درعاً في مواجهة قيام أنظمة على غرار نظام طالبان في أفغانستان. ولقبوا نظامه يلقب بتنين المغرب المقبل.
• وضع مع رئيس أمنه الخاص الفريق علي السرياطي خطة تقوم على أساس أنه في حال اضطراره على الرحيل يقوم السرياطي بإنزال عناصره للقيام بأعمال التخريب والإجرام كي يسيء لكل من يتظاهر ضده.وكي يوفر الغطاء للدفع بحرسه الخاص والجيش التونسي إلى الشارع بذريعة الحفاظ على الأمن. للقيام بانقلاب عسكري لصالح زوجته ليلى لتحل محله وتكون الرئيس لتونس من بعده.
• غيب نظامه وتونس عن القيام بأي دور, أو أسهام في التصدي للمخططات الاستعمارية التي تحاك ضد الأمة العربية. ولذلك ألتزم الصمت على غزو العراق, وعلى مشروع الشرق الأوسط الجديد, وعلى عدوان إسرائيل على لبنان وقطاع غزة, وحتى على حصارها لقطاع غزة.وألتزم الصمت عن تواطؤ قوى 14 آذار مع الإدارة الأميركية للنيل من قوى المقاومة الوطنية وسوريا وحزب الله.
• فشل زين العابدين بن علي في تجسيد مقولته التي كان يرددها دوماً:إن قوة مجتمع وعدم قابليته للخدش تكمنان أساساً في متانة الطبقة الوسطى وأتساعها.ولذلك أستورد نموذج الغرب الاستهلاكي كي يجذب الطبقة الوسطى إلى جانبه,أو يحيدها على الأقل.ولخص ذلك أستاذ جامعي بقوله:تستطيعون أن تأكلوا,وتشربوا,وتستهلكوا,وتمارسوا الجنس بقدر ما ترغبون,لكن لا تشتغلوا بالسياسة.
• تراجعت قيم الديمقراطية في ظل حكمه,بينما أزدهر المجتمع الاستهلاكي.على مبدأ أسكت وأستهلك.
• بات ثلث شركات النسيج الصناعي وعشرات آلاف فرص العمل مهددة بالزوال لعدم قدرتها على تحمل منافسة الشركات الأوروبية الأكثر نجاحا والأفضل استعداداً في هذه المجالات.
ويقال بأن الرئيس محمد حسني مبارك كان يخطط لاستقباله بمصر,كما استقبل شاه إيران من قبله.كي يقيم فيها طيلة حياته. إلا أن الاحتقان في الشارع المصري جعله يؤجل النظر بهذا الموضوع في الوقت الراهن. كما أن إذاعة شالوم التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني المغربي روبير الصراف, والتي تبث من باريس أعربت عن حزنها لسقوطه,وشنت هجوما على زوجته ليلى على أنها كانت هي السبب.وأن اللوبي الصهيوني ضغط على ساركوزي كي يدعم بن علي.كما أن وسائط الإعلام الإسرائيلي أعربت عن حزنها لسقوط نظام حكمه. وكذلك اعترفت الإدارة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية بأنهم فقدوا صديق وحليف كانوا يثقون به.
الأحد:30 /1/2011م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
البريد الإلكتروني: burhanb45@yahoo.com
bkburhan@maktoob.com
bkriem@gmail.com
من الخاسر بسقوط نظام مبارك؟
مصاب أليم حل بأرباب وأصحاب وأصدقاء وحلفاء وأحباب ومحبي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وهم في وجوم وذهول وحيرة.وخائفون من أن يصيبهم ما هو أشد منه وطأة,وأكثر نكبة وتصدعاً وخسارة.
فانتفاضة الشعب المصري على ما يبدوا لم تستوعبها الكثير من الأنظمة في الشرق والغرب.وإنما أكتفوا بتغيير ألوان جلودهم كما تفعل الحرباء حين تتقي من الخطر.فالنظام المصري المتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية والمرتبط مع إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد, والمدعم بالعديد من الأجهزة الأمنية والقمعية. والمنضوي في تحالف تقوده الإدارة الأميركية بما يسمى الحرب على الإرهاب. والمقترن بزواج لا طلاق فيه مع رموز الفساد ورجال الثروة والمال, وشركات الأمن والمرتزقة لم يفلح في وقف الانتفاضة.وحين تمادى النظام بتصرفاته الطائشة والحمقاء والغبية.تحولت الانتفاضة إلى ثورة شعبية عارمة.ولم تعد تنفعه محاولاته بإلقائه الملامة على غيره فيما حصل.أو توصيفه ملايين المتظاهرين في الساحات بأنهم رعاع وغوغاء يتحركون وفق أجندة خارجية. ولم يتمكن من إنقاذ رقبته بسياسة العصا والجزرة, ولا بأساليب التخويف والوعود الزائفة و تقديم الرشوة , وأساليب التهديد والوعيد والإرهاب والإجرام. حين زج بأجهزته الأمنية جنباً إلى جنب مع من في السجون من المجرمين والقتلة واللصوص إضافة إلى عصابات شركاته الأمنية التي تعج بالمرتزقة,رغم أنه عززهم بالسلاح والذخيرة والبغال والجمال والحمير للبطش بالمتظاهرين ليطفئوا لهيب نيران الثورة.مما نجم عنه تشظى النظام إلى ثلاث شظايا:شظية قوامها الرئيس وأسرته ونائبه تنحت ورحلت.وشظية حملت معها بعض رموز الفساد إلى السجون كي يكون الضحية التي يفتدي بهم النظام نفسه. وشظية استمرت لتكون الحاكم من بعد مبارك, والتي تضم ما تبقى من زبانية وعباقرة العمالة والخيانة والفساد كأبو الغيط وغيره.
وكم كان نظام مبارك عبيطاً وأحمقاً حين خرج رموزه من محمد حسني مبارك إلى عمر سليمان إلى رئيس الوزراء ووزير خارجيته أبو الغيط ي يخطبون ود الجماهير وشعوب العالم بكلام فارغ .قالوا فيه:أنه لا يوجد معتقلين أبداً, وليس لهم بأي علم عن وجود شهداء قتلوا على أيدي رجال الأمن وبعض المرتزقة. وأنه لا علم لهم بوجود بلطجية يفتكون بالمتظاهرين.أوفي دفاعهم المستميت عن الرئيس مبارك.وهم يرددون: بأن الرئيس رجل صالح وشارك في حرب أكتوبر عام 1973م,وهو أب للجميع,ولكن بعض من بطانته هي الفاسدة.أو حين راحوا يتغزلوا بالمتظاهرين. ويقولوا لهم: أنتم شباب حلوين, و عملتوا حاجة عظيمة,وعليكم منذ اليوم أن تخلوا الساحات.وإذا لم يتم الإصلاح عودوا مرة أخرى.فلقد أخذنا علما بمطالبكم وسوف ننفذها.ومن الضروري وقف الانتفاضة والعودة إلى بيوتكم بالحسنى,وإلا فإننا سنضطر لإخلائكم منها بكل ما أوتينا من قوة. كي لا يحصل فراغ دستوري.وأنهم بدئوا الحوار مع الأحزاب والجماعات الأخرى لتهجين النظام بأشكال أخرى!!!.
أما حلفاء نظام مبارك من المسلمين والعرب.فقد وقفوا كالطود لدعم النظام بكل ما لديهم من جبروت وقوة. وانهمكوا بترويج أو تسويق ما يروجه نظام مبارك. ويضيفون تهم لشعب مصر لم تخطر على أذهان رموز نظام مبارك.وجندوا وسائط إعلامهم لتكون بتصرف النظام وعلى رأسها فضائية العربية بقضها وقضيضها.وحين لم يفلح جهادهم وجدوا أنفسهم في حيرة.وسارعوا ليبعدوا الشبهات عنهم والألم يعتصر قلوبهم والحسرة تفتت أكبادهم لإطلاق التصريحات الرمادية.كقولهم مثلاً:بأن من حق الشعب المصري أن يختار نظامه وقيادته,وأن لشعب مصر الحق في إبداء رأيه وراح كل منهم يتوجس خيفة مما قد يحيق به وبنظامه من خطر. فمنهم من راح يعرض مكرمته برشوة بآلاف الدنانير لكل فرد من مواطنيه.كي يأمن جانبهم فلا يثوروا عليه, ويسببوا له وللإدارة الأميركية وإسرائيل المزيد من الإحراج والحرج. وآخر حول نظامه إلى جمعية خيرية.مهمتها إطعام مواطنيه لعدة أشهر مجاناً وعلى حساب خزينة دولته الموقرة.مطبقاً المثل القائل:أطعم الفم تستحي العين.وآخر راح يستغل الحدث كي يتسول مزيداً من الدعم من الإدارة الأمريكية.من خلال تصريحاته بأن مبارك كان يقدم الدعم لتنظيم القاعدة لينفذوا التفجيرات في بلاده.وآخر وجد أن خلاصه إنما يكون باتهام نظام مبارك على أنه استعان بفدائيي صدام لقمع الانتفاضة.وآخر وجد أن صمته ,مع تجاهل مجريات الثورة أجدى وأسلم له وأنفع.
أما حلفاء نظام مبارك من الإدارة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية فزلزال الانتفاضة أخذهم على حين غرة. فباتوا طريحي الفراش لا حول لهم ولا قوة, وكل واحد منهم يهذي بتصاريح كل منها يناقض ما كان قد سبقه. ولم تؤرقهم مناظر دماء المصريين وهي تراق من قبل أجهزة الأمن وعناصر مرتزقة نظام مبارك,ولا انتهاكات قيم الحرية وحقوق الإنسان وحرية التعبير من قبل جلاوزة النظام.بل كان وما يزال كل همهم أن تبقى المعاهدات التي وقعها النظام مع إسرائيل بأمان وسلام,وسارية المفعول فقط.ومن باب الإستعباط والضحك على الذقون يطلقون تصريحات تطالب المتظاهرين باحترام القانون وعدم اللجوء إلى العنف,والصبر على الضيم والجور. مشفوعة بمناشدتهم نظام مبارك أن لا يرفع من وتيرة جوره, وأساليب قمعه وإرهابه أكثر.وأن يستمر في الحكم حتى انتهاء ولايته الدستورية. أما الإدارة الأمريكية فكانت تحاول إعادة الإمساك بالخيوط التي تتحكم من خلالها بالسلطة في مصر.مع التحايل على الثورة لتضمن سلامة إسرائيل وحماية مصالحها في مصر والمنطقة.
أما إسرائيل فتحركت بسرعة وبنشاط.وراحت تمارس ضغوطها على الإدارة الأمريكية وعدد من الحكومات الغربية مطالبة إياهم بالتوقف عن توجيه النقد للرئيس المصري حسني مبارك ونظامه.منبهة إياهم أن بقاء مبارك ونظامه يمثل مصلحة عليا للغرب وإسرائيل. وحتى أن بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان كلفا سفراء إسرائيل في كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وعدد آخر من الدول,بالاتصال بمكاتب رؤساء هذه الدول,أو رؤساء وزرائها، علاوة على وزراء الخارجية.والإيضاح لهم أن الإبقاء على نظام مبارك يمثل مصلحة عليا للغرب ولمصالحه.وحتى أنه أوفد وزير دفاعه باراك لهذا الغرض.وراح رئيس المخابرات ووزير الأمن الداخلي السابق في إسرائيل آفي ديختر يهدئ من روع الإسرائيليين معتبراً أن تولي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان مقاليد الأمور في مصر يمثل أهم بشرى يمكن أن يزفها لإسرائيل.مبيناً للإسرائيليين أن عمر سليمان صديق قوي لإسرائيل، وهو ملتزم التزاماً كاملاً بمعاهدة كامب ديفيد. وعدو لدود لقوى المقاومة ودول الصمود ولإيران و لحركة حماس وحزب الله والحركات الإسلامية بشكل عام.وأنه ذو كاريزما ويمكن الوثوق به.كما أن وسائط الإعلام الإسرائيلية من صحف وفضائيات وجهت انتقادات حادة للموقف الذي أبدته الإدارة الأمريكية تجاه مبارك. ولخص وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق موقف إسرائيل بمقال نشره في صحيفة إسرائيل اليوم قال فيه:أنه يتوجب على الولايات المتحدة والعالم بأسره أن يقف إلى جانب مبارك ونظامه، على اعتبار أن سقوط هذا النظام سيمثل ضربة قوية للمصالح الأمريكية والعالم بأسره. وحذر أوباما من أن يكرر الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأسبق جيمي كارتر عندما لم يتخذ موقفاً حاسما لدعم شاه إيران. وقد أجمع عدد كبير من المعلقين الإسرائيليين على أن الثورة التي تشهدها مصر حالياً تمثل أفظع كابوس يمكن أن تتوقعه إسرائيل. وأعتبر بن كاسبيت:أنه فيما يتعلق بالمصالح الإسرائيلية فلن يصل لكرسي الرئاسة في مصر أفضل من حسني مبارك. وأجمع المعلقون الإسرائيليون على أن زوال مبارك ونظامه يتطلب إعادة النظر في العقيدة الأمنية،وإعادة رسم خارطة التهديدات التي تواجه إسرائيل مجدداً،مع الاستعداد بشكل مكثف لإمكانية تفجر الجبهة الجنوبية.وتوقعت صحيفة ذي ماركير, أن تحل بإسرائيل كارثة اقتصادية كبيرة بزوال نظام مبارك. وأن تضطر إسرائيل إلى زيادة موازنة الأمن بشكل كبير.مما يعني أنها ستكون مضطرة لتقليص النفقات في عدة مجالات.مما يعني توجيه ضربة للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل. وشددت على أن أهم النتائج الاقتصادية لسقوط نظام مبارك تراجع قيمة الشيكل, وتراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
كم هو محزن ذلك الخطأ الفادح الذي أرتكبه بعض القادة وبعض الأنظمة والحكومات الذين يدعون أنهم يحملون الهمين العربي والإسلامي حين وقفوا يدعمون نظام الرئيس محمد حسني مبارك!!!!!! وكم هو محزن موقف بعض الحكومات الأوروبية اللواتي أغمضن أعينهم عن تجاوزات نظام مبارك, وتعديه السافر والإجرامي على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير!!!!! وكم كان موقف إدارة الرئيس باراك أوباما والحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري ومجلسي الكونغرس الأميركي من انتفاضة الشعب المصري على نظام الطاغية محمد حسني مبارك وصمة عار جديدة على جبين بلادهم الولايات المتحدة الأمريكية!!!!!!
ونتمنى على الشعبين التونسي والمصري أن يعملا على متابعة إنجاز هذه المهام الأربعة التالية:
1. أن يجتثا كافة جذور نظامي زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك من السلطة مهما صغرت.كي لا يبقى منها جذر صغير يظهر له برعم, فينمو ويورق ويصلب عوده من جديد.
2. الإصرار على محاسبة ومحاكمة رأسي النظامين مع رموزهما ورموز الفساد على كل ما ارتكبوه من موبقات و وجرائم وسرقات.كي تبدوا الحقيقة ساطعة كالشمس للجماهير.وتفتضح ماهية العصابة بعناصرها وزعمائها الذين يكنون العداء لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ويدعمون أنظمة الطغيان والفساد. وينفثون سموم أحقادهم على العروبة والإسلام.ويقفون حجر عثرة في وجه التنمية والتطوير والإصلاح,ويسعون لإشعال نار الفتنة بين الأديان وبين الطوائف والمذاهب في كل مكان.
3. ممارسة الضغط على الدول أودعت في بنوكها أموال رموز الفساد ,أو التي بيضت فيها هذه الأموال إلى ملكية لعقارات وشركات وغيرها.كي يجمدوها ويعيدوها لخزينة كل من البلدين حسب العائدية.
4. التصدي للمخططات الاستعمارية التي تستهدف قوى الصمود والممانعة,وقوى المقاومة الوطنية,الذين يقفون بصلابة لإحباط المشاريع الصهيونية والاستعمارية, ومشاريع تقسيم وتجزئة الدول والأوطان.
وحينها تكون كل من الثورتين قد أنجزت مهامها.وساهمتا بفضح وإسقاط باقي أنظمة الطغيان والعمالة والفساد. وعروا العصابة التي تقود تنظيمات الإرهاب لتحقيق مصالح إسرائيل وقوى الصهيونية والامبريالية والاستعمار.
السبت: 19/2/2011م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
البريد الإلكتروني: burhanb45@yahoo.com
bkburhan@maktoob.com
bkriem@gmail.com
هل نجح الاعلام بالوفاء بوعوده؟
الكلام السياسي أو الحديث السياسي, هو قراءة الحدث أو المشكل السياسي بعلم وموضوعية ومنطق سليم. ومثل هذه القراءة تسهم في تحديد مكامن الداء ونوع الدواء. والتي قد لا يرضي في كثير من الأحوال طموح, أو أمل أو مبتغى المحلل السياسي. ولكنه يسرد أو يكتب الحقيقة ,كي تستفيد منها الجماهير.
والفرق كبير, والبون شاسع, بين محلل يقرأ الحدث أو المشكل السياسي على حقيقته دون تعديل وتحوير, أو تزوير , أو إضافة بعض الديكورات والملونات والرتوش . وبين محلل يقرأ الحدث أو المشكل بما يرضيه, ويتناغم مع طموح وهدف وأمل ومبتغى واسطة الاعلام التي تستضيفه ,كي يحقق كل واحد منهما مبتغاه.
نشهد في هذه الايام تحليلات سياسية من قبل بعض وسائط الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة, تتعارض وأخلاق مهنة الاعلام. فهذه الوسائط الاعلامية باتت تستقطب محللين سياسيين أو عسكريين أو اقتصاديين, يمارسون الخداع والتضليل, وإيقاد نيران الفتن. خدمة لبعض أسيادها من الحكام. أو خدمة لشركات الاعلان التي باتت صاحبة التأثير في معظم وسائط الاعلام, بما تضخه من أموال بذريعة أنها أجور اعلانات.
إذا كان الاعلام الرسمي العربي بنظر البعض هو الأبن الشرعي لواقعنا العربي ,لأنه يعكس الوضع العربي بدقة, بما يعتريه من إحباط وقمع وتشويه لعقل الانسان العربي. فإنه حال الاعلام الخاص بنظر الكثيرون ليس بأفضل. فحاله أسوأ بكثير من الاعلام الرسمي, رغم أنه يتمتع بهامش حرية اعلامية أوسع ,او بحرية مطلقة كما يدعي. إلا أننا بتنا نلاحظ, أنه محكوم بأمور عدة. من أبرزها: خدمة ملاكه من خلال الترويج لنهجهم السياسي والاقتصادي والاستهلاكي. وغياب حس الشعور الوطني والقومي. و ممارسته التضليل الاعلامي الممنهج والمتعمد. وخاصة حين يلجأ لتجاهل أحداث رئيسية وإبراز أحداث ثانوية. وإيقاد نار الفتن الطائفية والمذهبية. وتحويل بعض البرامج إلى أساليب قدح وسباب وشتائم لا تليق بمن يديرها ولا تنسجم مع قواعد الدين والأدب والتربية والاخلاق. لتحقيق غايات شخصية مقيتة ,أو للتنفيس عن أحقاد مزمنة. أو نشر برامج تدفع بجيل الشباب نحو الانحراف والضياع ,أو تخريب المجتمعات. وبات الاعلام الخاص الذي يدعي تحرره من القيود الرسمية مكتنز بالكثير من الاسفاف والهزل والتطاول على القيم القومية الوطنية والاخلاقية, وحتى الإجتراء على الديانات, و أمن البلاد والعباد. يدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان بأمكنة ,و يتجاهلها في أكنة أخرى .ويحارب الديكتاتوريات والفساد في دول, ويتجاهلها أو يذود عنها في بلاد أخرى.
الفرق كبير بين الإعلام العربي والإعلام الغربي في كثير من الأمور. فالإعلام الغربي بشقيه الرسمي والخاص يخدم مصالح بلاده, ومصالح مجتمعاته. و ينأى بنفسه عن كل ما يهدد أمن بلاده القومي, أو أمن مجتمعاته. رغم أنه يعاني من مثالب وآفات, كالصمت عن إرهاب وعدوان وإجرام, وأشبه بمن بكتم شهادة حرمها الله. وحتى ترويج الأكاذيب بهدف خداع وتضليل الجماهير بذرائع الدفاع عن الأمن القومي وعدم إضعاف معنويات جنوده الذي يخوصون الحروب ويمارسون العدوان على بعض الدول. فالإعلام الغربي يعتبر أنه بالدعاية يمكن ترسيخ أفكار ,وتبديل مواقف بعض الاشخاص والجماعات. وحتى التأثير في شرائح كثيرة من المجتمعات .والدعاية لديه أصناف وأشكال. دعاية استراتيجية. ودعاية داعمة .ودعاية تعبوية .ودعاية مضادة. ودعاية مفرقة للصفوف .ودعاية بيضاء .ودعاية رمادية ودعاية سوداء ,وإشاعات مغرضة. ويقال: إذا أردت اغتيال عدو لا تطلق عليه رصاصة ,أطلق عليه إشاعة. ويعتبر أن الدعاية تعتمد في تأثيرها على شخصية الداعية وأسلوبه في بث الدعاية. وأن أخطر الشخصيات الدعائية عادة هم الأفراد الذين يطلق عليهم تسمية مستقطبي الرأي العام ,أو من أصحاب المواهب المميزة. ولذلك يختار أخصائيين وخبراء وشخصيات دعائية في الاعلام لممارستها على الوجه الأكمل. ويستضيف محللين سياسيين واقتصاديين وعسكرين لإلقاء مزيداً من الضوء على بعض جوانب الحدث لتحقيق اهداف جمة. منها ما تخدم مصالح بلاده, أو يجد فيها المبرر للاستخفاف ببعض المجتمعات والدول. وتوظيفه الحدث لتبرير منطق وموقف حكومات بلاده العدواني أو المزدوج أو الرمادي أو الأسود. و يتخذ منه ذريعة للنيل من مواقف بعض الحكومات والدول تجاه هذا الحدث, للتأثير عليهم تجاه قضايا أكثر الحاحاً من هذا الحدث ,ولتعزيز بعضاً من مصداقيته أمام الناس. فالإعلام الغربي مؤسسات كبيرة لها وظيفتها ولها دورها الفاعل في السياسة والاقتصاد والحرب والأمن والسلام. و هي من تحرك الإعلاميون في كل أتجاه وفق ما ترغب وتشاء. وحين تستضيف محلل سياسي أو اقتصادي تختاره من النخبة في بلد ما, وممن له دور فاعل في صفوف المعارضة أو الموالاة. والمضيف يحشر ضيفه بأسئلته المحرجة ,أو ببعض الوقائع والتعقيبات والحقائق, كي لا تتحمل واسطته الاعلامية أية مسؤولية قانونية عن إجابات وتصرفات هذا المحلل حين يلجأ للقدح والشتائم . لكي يكشف للمشاهدين أو القراء, حال النخبة في هذه البلاد. وأن هذه البلاد مصيرها الشقاء, ولن تنعم بالأمن والتمية والاصلاح والاستقرار.
أما الاعلام العربي الرسمي والخاص: فهو مؤسسات عدة تتصارع فيما بينها ,وليس لها من دور فاعل على أي صعيد من الأصعدة .سوى أما في الدفاع عن الأنظمة والحكومات والحكام. أو في التهجم على أنظمة وحكومات. أو شرذمة وتفتيت المجتمعات ,ورفع حدة الصراعات والتناقضات, وحتى إيقاد نيران الحروب والفتن داخل المجتمعات العربية. وطمس معالم العدوان الصهيوني والاستعماري على بعض أجزاء وطننا العربي. فصديق اليوم قد يكون العدو اللدود في الصباح, وحليف اليوم قد يتحول إلى عدو في الظهيرة أو المساء.
وبعض الاعلاميين ممن يتحكمون في واسطة الاعلام, هم رأس مال بعض وسائط الاعلام .وهم نجومها, وربما على كاهلهم تقوم مثل هذه الوسائط .فهم ملوكها المتوجين. وهم من يختارون نوعية البرامج, ونوعية الضيوف. والبعض منهم تتلمذ وأمتهن الاعلام في دول أجنبية, ووسائط اعلام غربية, وأقصي عنها لسبب من الأسباب. أو تطوع للعمل في وسائط اعلام عربية, لخدمة أهداف أمته ووطنه, لينقل إليها بعض ما أكتسبه من خبرات. والغريب حين يستضيف هؤلاء بعض المحللين, ينزلقون بدروب تجهض كل حوار ومفاوضات واتفاق. وحتى السير بمسارات تكون من نتيجتها تمزيق اللحمة الوطنية لكل بلد. ولذلك نجد راية الخلاف والشقاق والصراع خفاقة دائماً في أكثر من برنامج ولقاء. و البعض من المشاهدين أو المستمعين أو القراء يخرجون بانطباع أن مصائب الشعوب سببها قوى المقاومة الوطنية ,وثورات الشعوب على نظم الوصاية أو الانتداب. وأن الأمة العربية لا تعرف شيئاً سوى الفرقة والاختلاف. وأن الشيء الوحيد الذي تتفق عليه هو أن لا تتفق. وأنها منذ الأزل أمة تحكمها النزاعات. وأنها ليست أمة واحدة كما تعلمنا في المدارس والجامعات, وإنما شعوب متناحرة. وأن اتفاقيات سايكس بيكو كانت نوعاَ من العلاج. وأن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كونداليزا رايس سيكون العلاج, والحل الامثل لكل ماتعاني منه من مشاكل وصراعات ومعضلات.
ولذلك نجد بعض وسائط الاعلام صفر الضمير وكأنها تشترى وتباع .وأن بعض رجال الاعلام لم يعودوا محامون يدافعون عن الناس بلا أجور وتوكيلات, وإنما تجار اعلام, يتاجرون بالمشاكل والمآسي والنكبات.
لذلك يقول البعض أن الاعلام العربي هو أحد مدرستين : مدرسة تتعامل جمهورها بمنطق: لا تَقْل ما تريد فنحن نفعل ما نريد. ومدرسة تتعامل مع جمهورها بمنطق: قُل ما تريد ونحن نفعل ما نريد.
كان نابليون يقول: الصحافة ركن من أعظم الأركان التي تشيد عليها دعائم الحضارة والعمران. ويقول أيضاً: إني أوجس خيفة من ثلاث جرائد أكثر مما أوجس خيفة من مائة ألف مقاتل. والمضحك أنه هو من جر جيوشه ليحارب في أوروبا على أكثر من جبهة ومكان ليدمر البلدان. وكأن الصحافة كانت تؤيده في هذه الأفعال. وجفرسون قال: عندي أن أعيش في بلاد بها صحافة وليس فيها قانون ,أفضل من أن أعيش في بلاد بها قانون وليس فيها صحافة. وبلاده الولايات المتحدة الأمريكية فيها اليوم العديد من مؤسسات الاعلام والتي تصدر فيها مئات الصحف والمجلات والدوريات, إضافة إلى مئات الفضائيات والاذاعات. وتفاخر بأن قانونها ودستورها الأفضل والامثل بين كل الدساتير والقوانين. ومع ذلك تمارس إدارتها الارهاب والاجرام والعدوان.
يعتبر البعض ان الصحافة قد تكون صناعة جيدة في كل اللغات ما عدا لغة الضاد. وجبران تويني قال: الصحافة رسالة واستماع وقناعة ومرض بالدم…….. والاعلام المقروء العين, الفرد فيه يسجل ,والفكر يحلل ويستنتج. والاعلام المرئي ,فالمشاهد يتلقى, فهو سطحي وسريع. وهل صحيفة النهار تلتزم بهذا الكلام؟ وشهيرة الرفاعي قالت: رئاسة التحرير مسؤولية كبيرة ,ورهبة, وتحد كبير, لإثبات الذات. وهل رؤساء التحرير ومدراء وسائط الاعلام مقتنعون بهذا القول؟ وهل لهذا القول من وجود في بعض وسائط الاعلام؟ ويقول المثل الياباني: أبحث سنوات قبل أن تصدق خبراً. والمثل الأمريكي يقول: لا تتوقع أن يأتيك الصدى بأي جديد. ومارك توين قال: النساء أهم من وسائل الاعلام لنقل الأخبار بسرعة .وتضخيمها بحيث تصبح الحبة قبة.
في عالم الاعلام تسمع الكثير من الوعود, ولكنك لن تجد منها سوى القليل. حيث يقول الاعلاميون:
• علينا أن نجعل الاعلام وسيلة لإيصال الثقافة بمختلف تجلياتها للجماهير.
• وأنه لا مكان للواقفين في مكانهم أبداً…. لابد من التطوير والابتكار والتغيير, ولابد أن نأتي بجديد ومتجدد وأيضاً مدهش .لنكسب ثقة الجماهير. وأن نظهر الحقيقة للناس دون تزييف أو تمويه.
• وأنه لابد من الابحار في بحر التكنولوجيا المتلاطم, وبحر المعلومات المتدفق مهما كلف الأمر.
• ولا بد من التفكير فيما يفكر فيه الجمهور ,وما يقبله, وما يرفضه, وما يحلم به ويتمناه. وما نأمل أن نوصله إلى الجماهير لكي يحدث التلاقي بين المرسل والمستقبل.
• ولابد من مواكبة الاحداث واهتمامات الناس بدون تناقض مع الوقت.
• ولابد من التنافس لتحقيق السبق الصحفي والاعلامي في كل الأمور والأحداث.
• ولابد من احترام الرأي والرأي الآخر, ورأي المعارضة والموالاة, وذلك بإفساح المجال للجميع.
• والتعامل بأخلاق ووجدان ومنطق وقانون في التعامل مع الأحداث والمشكلات.
• والابتعاد عن ازدواجية وتعددية المواقف ,وأسلوب المحاباة في التعامل مع الأحداث,
ونتوجه بالسؤال إلى بعض وسائط الاعلام: هل نجحت في تنفيذ وعودها .وهل تمارس الدعاية بوجهها الصحيح. ولماذا تستضيف ضيوف ومحللين سياسيين يلجؤون إلى التضليل وتشويه البرامج وتزييف التحليل؟
الثلاثاء:10 /7/2012م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
bkburhan@hotmail.com
هنري كيسنجر يطل علينا من جديد
ثعلب السياسة السيد هنري كيسنجر بلغ من العمر عتياً, إلا أنه خائف على مستقبل بلاده وإسرائيل.
غاب كيسنجر عن المسرح السياسي الأميركي, إلا أنه لم يغب عن وسائط الإعلام وشاشات الفضائيات. ولم يترك مناسبة أو مشكل سياسي أو حدث, إلا راح يمحصه ويعطي رأيه , و يقدم نصائحه,وهذه إحدى وصفاته:
أفضل فكرة هي استغلال الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية الجماهيرية, كوسيلة لتوحيد الأمم(بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية) في نظام عالمي من خلال الفوضى. فالأزمات والاضطرابات هي مجرد وسيلة يستخدمها بلد معين آخر لتحقيق هدف كوني. وسوريا مجزأة هي أفضل نتيجة للولايات المتحدة الأميركية. وأنا أفضل التخلص من الرئيس الأسد. وخلافنا مع الروس, هو أن الروس يقولون: أنتم لا تبدؤون بمحاولة التخلص من الأسد, فهذا ليس هدفكم الرئيسي, بل بتحطيم إدارة الدولة, ومن ثم ستكون هناك حرب أهلية أسوأ بكثير. هكذا وصلنا إلى هذه الفوضى الحالية.
وهنري كيسنجر على ما يبدوا محزون, أن يكون آخر وزير للخارجية الأمريكية لحقبة من الزمن, كانت وخلالها وزارة الخارجية هي من كانت تتحكم بالقرار الأميركي, وبالمشهد السياسي,وهي من تقود السياسة الأميركية. والسيد كيسنجر غنيٌ عن التعريف, فهو من خطط وأشرف على طي صفحة حرب فيتنام, وهو من فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلاده والاتحاد السوفييتي والصين, وهو من أنقذ إسرائيل من المصير الأسود الذي كان ينتظرها في حرب تشرين عام 1973م, وهو من خطط للحرب الأهلية في لبنان,وهو من صاغ اتفاقيات فصل القوات برحلاته المكوكية, وهو من مهد لاتفاقيات سيناء و كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
و يفاقم حزن السيد كيسنجر, قلقه وخوفه على بلاده, بعد أن تحولت وزارة الخارجية الأميركية من بعده, إلى تابع للبنتاغون, و أجهزة الأمن القومي الأميركي, و بعض موظفي و متدربي البيت الأبيض. بعد أن تسلم زمام أمورها شخصيات كأولبرايت و رايس وهيلاري كلينتون ,تسمع لها جعجعة ولا ترى لها من طحين. وأحتل المسرح السياسي الأمريكي لأكثر من ثلاثة عقود ساسة مؤهلاتهم الجهل, وضعف الخبرة والمهنية, وقلة الحيلة والتردد, والثرثرة, والِكبر , مع مخزون كبير من العدوانية والكراهية, من السفير والمستشار إلى الوزير والرئيس ونائب الرئيس. مما دفع ببلاده والعالم إلى هذا المنحدر الخطير من عدو الاستقرار وغياب الأمن.
لم يحزن كيسنجر يوماً على ما أصاب العالم من كوارث ونكبات ودمار لحقت ببعض الشعوب والدول بفعل ما جنته يداه, أو ما نجم عن سياسات أشرف على تنفيذها, أو أسهم بوضعها. وإنما كل ما يحزنه هو: الأخطار المحدقة التي باتت تهدد إسرائيل, وتعطل دور بلاده في قيادتها للعالم. بعد أن استعاضت إدارتها عن الفوضى الخلاقة التي خطط لها كيسنجر,إلى هذه الفوضى الفوضوية الحالية. و نجم عنها تداعيات باتت ترعبه,ومنها:
• رغبة ضاغطة من الشعب المصري لإستعادة موقع ووزن ودور مصر التاريخي.
• تصريحات حكام إسرائيل المتناقضة. ومنها قول الجنرال أفيف كوخافي قائد شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان): ثلاث تحديات تواجه إسرائيل هي: الاقتصاد والثورات و الأسلمة.
• خشية الدبلوماسية الغربية, من أن يتحول عدم سقوط نظام الرئيس الأسد إلى كابوس سياسي وأمني, يلاحق دول المحيط, ويؤدي إلى سقوط حكومات أوروبية وإقليمية, بدأت بشائرها بسقوط حمد ومرسي. واحتجاجات ساحة تقسيم بتركيا, التي هي ذات خلفيات سياسية وانتخابية بامتياز.
• وتصاعد صراعات الخلافة في بعض الدول, سيضع إدارة أوباما في حرج.
• والضربة الموجعة للولايات المتحدة الأمريكية, بإعلان أذربيجان في 26/6/201م, عن انسحابها من مشروع خط أنابيب الغاز نابوكو, الذي يضم كلاً من تركيا بلغاريا ورومانيا وهنغاريا. ولجوؤها إلى تصدير منتجاتها النفطية إلى أوروبا عبر خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي, والذي يشمل اليونان وألبانيا وإيطاليا (مشروع آكسبو),وتملك سويسرا حصة 42,5% ,وشركة ستات أويل النرويجية 42,5%,وشركة أي أون رورغاز الألمانية 15%. وهو ما ينهي أي أمل في الحياة لمشروع خط الغاز الأميركي المنافس لخط الغاز الروسي.
• والقلق من عودة اللغة الناصرية المناهضة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
• وتخبط وزارة الخارجية الأميركية ووزيرها جون كيري,كشفه وزير الخارجية الروسي لافروف ,حين قال بعد اجتماعه مع كيري في برناوي: أن الإدارة الأميركية باتت تعتبر أن مفتاح عملية الحل السياسي للازمة في سوريا يكمن الآن بجمع المعارضة السورية وتوحيدها على أساس بيان جينيف الصادر في 30/6/2012م. إلا أن ما نشره موقع كومير سانت عن مصدر روسي,يناقض قناعة كيري, حيث قال المصدر الروسي: في واقع الحال الولايات المتحدة الأميركية لا تريد عقد جينيف2. وهذا معناه أن جون كيري مازال عاجز عن اتخاذ القرار بسبب الهوة بين قناعاته وقناعة ساسة بلاده.
• وسياسة أوباما في الشرق الأوسط تلقت ضربة صعبة وموجعة. سببها فشل أوباما في التوصل لحل سياسي وسط بين مرسي وقوى المعارضة المصرية.وهذا الفشل سيدفع بمزيد من التصعيد والخلاف على الساحة المصرية بين حركة الأخوان المسلمين, وقوى المعارضة, و الحركات السلفية.
• وفشل تهديدات الجنرال مارتين دمبسي رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية للجنرال صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان المصرية, والتي لمح له فيها بأنه إن لم يقم الجيش المصري بالاعتدال في مواقفه, فإن واشنطن ستدرس قضية المساعدات العسكرية السنوية للجيش المصري, والتي تقدر ب 1,3 مليار دولار .حيث يعتبر هذا المبلغ المصدر الرئيسي لميزانية الجيش المصري.
• وغياب موقف أمريكي واضح من إقصاء مرسي عن سدة الرئاسة في مصر, بسبب تضارب وتناقض مواقف الساسة الأمريكيين, قد يشعل حريق في منطقة الشرق الأوسط يلتهم اليابس والأخضر.
• وتزلف مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بإشادتها بمكانة الأردن ,كحليف للولايات المتحدة الأميركية, الذي وافق على استضافة قوات عسكرية أمريكية على أراضيه. وطمأنة المؤسسة الأردن, بأنه لن يدخل في أجواء الربيع العربي.
• اعتماد الحل السلمي للملف النووي الإيراني, وعدم اللجوء إلى استصدار قرار بإعلان الحرب أو طرحه للتداول أو التصويت عليه.والتركيز على الهدف الأسمى لدرء نشوب حرب, وليس الترويج لها.
• القلق الأمريكي والإسرائيلي, من تجرع العسكر من محمد حسنين هيكل ورجال الفكر العربي جرعات الإلتزام بالخط القومي.وإصرار غالبيتهم على فتح قنوات اتصال واعدة مع موسكو والصين.
• وجود انقسام عامودي في السياسة التركية, بين مؤيدي ومناهضي سياسة حزب الحرية والعدالة الحاكم. وأن مطالب الطبقة الوسطى,والعلمانيين والليبراليين, ليست موجهة بالضرورة ضد سياسات حزب الحرية والعدالة, بل تنحصر في مطالبتهم بمنح مزيد من الحريات الفردية والعامة, وتطبيق أفضل للديمقراطية التي لا يجيدها أردوغان. ولجوء بعض المسئولين الأتراك توجيه الاتهامات يمنة ويسرى, لترسيخ نظرية المؤامرة الشاملة, للتمسك بها كقشة كي تنقذهم من الغرق, وهذه التصرفات قد تدفع بالجيش التركي للعودة إلى الواجهة مجدداً.
• والاحتجاجات على سياسة أردوغان, وهجوم رئيس الوزراء أردوغان على أرث المؤسس أتاتورك, زعزعت قبضة أردوغان وحزبه القوية على البلاد. وتنامي وتيرة الاحتجاجات, هي من ستحدد الاتجاه, الحالي والمستقبلي لتركيا, إما نحو الإرث العثماني لأردوغان, أو نحو علمانية أتاتورك.
• والفضائح التي تعصف بالإدارات الأميركية , باتت تهدد مستقبل الولايات المتحدة الأميركية, وتوهن من اتحاد ولاياتها. وهي الوثائق كشفتها صحيفة الواشنطن بوست, حول تركيب وكالة الأمن القومي معدات خاصة لدى بعض كبرى شركات الإنترنيت, مثل مايكروسوفت و ياهو و غوغل والفيسبوك, و آبل و يوتيب, للتجسس على كل ما له حساب على هذه المواقع. بحيث تتيح للوكالة الحصول على المعلومات منها, وإجراء المراقبة بشكل مستمر. وهذا يدحض ويكذب نفي الشركات المعنية, تعاونها في برنامج بريسم, أو عدم علمهم بوجوده. إحدى الوثائق حددت تاريخ انضمام هذه الشركات إلى برنامج بريسم. وهذه الفضيحة عرت شركات المعلوماتية من مصداقيتها.
• وتعاون دول العالم مع روسيا والصين, بات هو الخيار المستقبلي لقوى دولية صاعدة.
• واتهام الرئيس بشار الأسد لمشروع الإخوان المسلمين بأنه مشروع منافق, يهدف لخلق فتنة في العالم العربي, هو اتهام صريح للرئيس الأميركي أوباما وحلفاء بلاده من الأوروبيين والعرب.
• و أوباما محبط بعد أن أحبطت مساعيه بإيقاد نار الفتن الدينية والمذهبية في مجتمعات واعية.
• وسقوط حاكم قطر السابق والرئيس المصري محمد مرسي, قد يطوي صفحة لعبة استبدال الأنظمة التي أقرها الناتو عام 2010م. كما انه مؤشر على أن التآكل بدأ يضرب بأطنابه حلفاء بلاده.
• وسقوط حاكم قطر ومرسي, أحرج جناح حماس الذي يتزعمه خالد مشعل. والصراع بين الأجنحة داخل حماس سيشتد ويتصاعد , وربما قد يحسم لصالح الجناح الذي يتمسك بالنهج المقاوم.
• وانتهاج بعض المنظمات الإقليمية سياسة إقصاء, أو تجميد عضوية بعض الدول زاد الطين بلة.
• ومنظمات الإغاثة الدولية افتضح دورها المسيس والمشبوه, بغيابها المقصود عن الساحة السورية.
لا ندري إن كان السيد هنري كيسنجر سينصح إدارة الرئيس أوباما أن تعيد النظر بمجمل سياساتها؟ أم أنه سيضغط مع بقايا فلول المحافظين الجدد في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إدارة بلاده,لإجبار الأنظمة العربية والإسلامية المتحالفة مع بلاده, على دفع ثمن ما أصاب الولايات المتحدة الأميركية من ضرر و تشويه لسمعتها وتهديد لمصالحها, من أموالها وسمعتها؟ وهل ينوي السيد كيسنجر الضغط على إدارة أوباما, للتحرك من خلف الستار لتحميل مسؤولية فشل سياسات بلاده لبعض الحكام والأنظمة وبعض الإعلاميين وبعض رجال الدين, ومحاسبتهم ليكونوا أشبه بأضاحي تكفر بهم عن نفسها ما اقترفته بلاده من خطأ وأثم ؟
الاربعاء: 10/7/2013م العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم
burhansyria@yahoo.com
من بعد التحية
اتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. و أرفق مقالي الجديد ومقال سابق راجياً التكرم بنشرهما, وتقدير وضعي بعد أن هجرت من بيتي بسبب الاحداث وبات علي الاتصال معكم بمنهى الصعوبة وبكلفة لا أستطيع تحملها. واعتماد عنوان بريدي الالكتروني المدون أسفل المقال .لأن العنوان لتالي(bkburhan@hotmail.com) تم تهكيره وسرقته. ودمتم بحفظ الله ورعايته.