
بعد فترة من الهدوء النسبيّ للتوتّر المغاربيّ الأبرز، عاد النزاع إلى التجدّد بعد قيام مجموعة من نشطاء جبهة “البوليساريو” بقطع الطريق الرابط بين الصحراء الغربيّة و موريتانيا في المنطقة المعروفة بمعبر الكركرات أواخر شهر أكتوبر 2020، وهي منطقة عازلة تمتدّ على خمسة كيلومترات بين الجدار الترابي الذي شيّدته المغرب و الحدود الموريتانيّة.

تصف الجبهة ذلك المعبر بالثغرة غير القانونيّة و تعتبرهُ خرقا لخطوة التسوية وللاتفاق العسكري عدد 1 الذي يضبط وقف إطلاق النار بين الطرفين، في حين كانت لنفس المنطقة أهميّة حيويّة كبرى لدى الطرف المغربيّ لأنها تمثّل المنفذ البري الوحيد الذي ييسّر الحركيّة التجاريّة المغربيّة تجاه بلدان غرب أفريقيا. وعليه، لم يتأخر الرد المغربيّ على الحادثة كثيرا، حيث قامت القوات المسلحة المغربيّة بطرد هذه المجموعة في 13 نوفمبر من نفس السّنة، وكانت الذريعة هنا إنسانيّة، على اعتبار تواجد مائتين من سائقي الشاحنات المغاربة المحاصرين على الحدود الموريتانيّة الذين لم يتمكّنوا من العودة. ركّزت القراءة المغربيّة للحدث على أنّ إقدام جبهة البوليساريو على غلق الطريق كان محاولة منها للتأثير على قرار مجلس الأمن حول تمديد بعثة “المينورسو” في الصحراء الغربيّة والتعجيل بتنظيم الاستفتاء، غير أن الحادث في عمقه لم يكن إلا تتويجا لمسيرة كاملة من السباق الإستراتيجي الجزائري-المغربيّ الذي ساد خلال العقد الثاني من الألفيّة.
ديناميكيّة جديدة للتوتّر
كانت السنوات الخمس الأخيرة علامة فارقة في هذا التنافس بامتياز. فقد ركّزت المغرب جهودها بشكل دؤوب على العودة إلى إفريقيا جنوب الصحراء من بوابة المشاريع الإستراتيجية والزيارات الرسميّة المكثّفة للمسؤولين المغاربة، وصولا إلى تخلّي المغرب عن سياسة الكرسيّ الفارغ ضمن الإتحاد الإفريقي في جانفي 2017 بعد 33 سنة من الغياب عن المنظمة القاريّة الأبرز احتجاجا على قبول عضويّة البوليساريو.كما اتجهت الجزائر إلى دعم تواجدها في الفضاء الإفريقي، عبر الطريق الصحراوية التي تربط مدينة تيندوف الجزائريّة بموريتانيا تعزيزا للارتباط الإفريقي للجزائر، مع القلق الجزائريّ الملحوظ، خصوصا من المؤسّسة العسكريّة، من عمليّة فتح قنصليّات أجنبيّة في الصحراء الغربيّة الذي يعدّ بالنسبة لها نذيرا لاعتراف دوليّ واسع بمغربيّة إقليم الصحراء.

كانت حادثة الكركرات بالذات، هي شرارة اللهيب الذي انكفأ سنوات عديدة تحت الرماد، لتتسارع على إثرها حلقات مسلسل التصعيد بين الجارين اللدودين منذ انخراط المغرب في الاتفاقيات الإبراهيمية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020 تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل مقابل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة، إذ تلى تلك الخطوة إعادة فتح مكاتب الاتصال المتبادلة التي تطوّرت فيما بعد إلى سفارات قائمة الذات.
كعلامة على هذا التوتّر، شهد النصف الأول من سنة 2021 مناورات عسكريّة متعدّدة على جانبي الحدود. ففيما قاد رئيس هيئة الأركان الجزائريّة سعيد شنقريحة عمليّة تدريبيّة واسعة للجيش الجزائري بالذخيرة الحيّة في المنطقة العسكريّة الثالثة بتيندوف قرب الحدود المغربيّة أواسط شهر جانفي، احتضنت المغرب بدورها جزءا من مناورات الأسد 21 خلال شهر جوان 2021، وهي تدريبات أشرفت عليها قوات الأفريكوم الأمريكيّة بمشاركة حلف شمالي الأطلسي وقوات من 9 دول. زادت هذه المناورات من توجّس الجزائر خصوصا وأنّ عددا من المناورات الجويّة قد تمّ في قاعدة جرير لبوحي المغربية التي تقع على بعد كيلومترات فقط من الصحراء الغربيّة وغير بعيد كذلك عن الحدود الجزائريّة.

كلّ هذه التراكمات ساهمت في تعفين الجوّ العام بين الطرفين ليدخل النزاع منعرجا جديدا عقب دعوة مندوب المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال إلى “استقلال شعب القبائل” (حسب تسميته) عن الجزائر، خلال اجتماع دول عدم الانحياز الافتراضي يومي 13 و14 جويلية الماضي. وجاء هذا التصريح كنوع من الرد على إعلان وزير الخارجيّة الجزائريّ رمطان لعمامرة سابقا دعم بلاده حقّ تقرير مصير سكان إقليم الصحراء الغربيّة. لم تتأخر الجزائر في شجبها للتصريحات حيث استدعت سفيرها في الرباط للتشاور واعتبرت الموقف إشارة واضحة لدعم مغربيّ لحركة انفصاليّة قبائليّة (وتقصد بذلك الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل “الماك” التي صنّفتها في ماي الماضي كحركة إرهابيّة). كما بيّنت مصادر جزائريّة، أنّ المغرب قد وزع مذكرة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تهدف لما أسمته “دعم حق تقرير المصير للشعب القبائليّ”. هذا فضلا عن تداعيات أزمة برنامج “بيغاسوس” التي أكدت فيها عدد من الصحف والمنظمات الغربيّة استعمال المغرب لهذا البرنامج التجسسي إسرائيليّ المنشأ بغرض مراقبة مسؤولين جزائريّين داخل وخارج البلاد بين سنتي 2017 و2019 وجلّ هؤلاء كان من القيادات الأمنية والعسكريّة. كلّ هذه المراحل كانت تُنبأ بأن أفق الحلّ قد بدأت تضيق شيئا فشيئا، وأن الخلاف ماض نحو التصعيد.
التطوّرات الأخيرة والتداعيات الإستراتيجيّة
بدأ خطاب الاتهام الجزائريّ يأخذ شكلا من الحدّة مشيرا إلى دعم مغربي لحركتين معارضتين هما “الماك” و”رشاد”، ادعت السلطة الجزائريّة تورّطهما في عمليّات إشعال الحرائق التي طالت جزءا من النسيج الغابيّ الجزائريّ خلال شهر أوت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 90 جزائريّا من بينهم 33 عسكريّا. تزامن الحدث كذلك مع تصريح وزير الخارجية الإسرائيليّ يائير لابيد في الأراضي المغربيّة الذي عبّر عن قلقه من أفق التقارب الجزائريّ الإيراني في المنطقة وعن اشتراكه مع المغرب حيال تلك المخاوف واتّهامه الجزائر ب”قيادة حملة ضدّ قبول إسرائيل في الإتحاد الإفريقي بصفة مراقب”. اعتبرت الجزائر هذه التصرّفات كمبررٍّات كافية كي تعلن قطع علاقاتها مع المغرب في 24 أوت 2021 مع الإبقاء على العلاقات القنصليّة. ورغم الاتصالات الإقليميّة التي حاولت التوسّط لحلّ الأزمة ومن بينها خاصّة الجهود المصريّة والسعوديّة، بقي الموقف الجزائريّ ثابتا مع تواصل التصعيد المتبادل. ليتلو الرد الجزائريّ خطوات أخرى من بينها غلق المجال الجوّي الجزائري أمام رحلات الطيران المغربيّ وقرار الجزائر عدم تجديد خطّ أنابيب الغاز الذي يربط بين الجزائر وإسبانيا مرورا بالأراضي المغربيّة في أواخر شهر أكتوبر.
يعدّ خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي الذي بدأ العمل به في سنة 1997 من مشاريع التكامل الاقتصاديّ الناجحة رغم توتّر العلاقات، إذ كان بمثابة شعرة معاوية التي فرضتها مصالح الاستراتيجيا الاقتصاديّة وسط تقلّبات المناخ السياسي. كانت الاستفادة المغربية مضمونة من هذا الخط الممتدّ على 2136 كم انطلاقا من الشرق الجزائريّ، الذي تتولّى إدارته شركة “متراكاز” من مدينة طنجة المغربيّة، إذ وفّر لها نسبة مستقرّة تصل إلى 10 بالمائة من الغاز الجزائريّ المسال كمقابل لمروره من الأراضي المغربيّة، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء الطاقيّة للبلاد بشكل ملحوظ. لكن عدم الاستقرار السياسي وقرب انتهاء مدة الاتفاقية في نوفمبر 2021 دفع المغرب إلى التفكير منذ أمد في بدائل أخرى، عبر تطوير عمليّات التنقيب عن البترول والغاز في مناطق شمال المغرب والسعي إلى إحداث خطّ أنابيب جديد، يمتدّ من نيجيريا إلى إسبانيا عبر المغرب لتجاوز المساومة الجزائريّة الطاقيّة حال حدوثها.

بالنّظر في موضوع جيوبوليتيك الغاز، نجدُ أن للمسألة أبعادا متشابكة تبدأ بالفضاء المغاربي لتشمل مجالات إقليميّة أوسع. إذ تسعى الجزائر إلى تعويض الكميّات المنقولة في الخط القديم بخط آخر يمرّ تحت البحر المتوسّط يربط ميناء “بني صاف” غرب الجزائر بميناء ألمريا في الجنوب الإسباني، تبلغ سعة نقله 8 مليارات متر مكعّب من الغاز سنويّا. لكن تبقى هذه الكميّة دون التزامات الجزائر حيال حرفائها الغربيّين، فالواردات الإسبانية من الغاز الجزائري تصل لوحدها إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعّب في السّنة تُضاف إليها أكثر من مليار ونصف مليار متر مكعّب تُصدّرها الجزائر للبرتغال عبر الخط الأورومغاربي الذي كانت سعته تصل إلى 13 مليار متر مكعّب من الغاز سنويّا. ولمواجهة ذلك، ستسعى الجزائر الآن للترفيع في طاقة نقل خط الأنابيب البحري الجديد إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعّب في حين ستوفّر الكمية المتبقية من الطلبات الإسبانيّة عبر النّقل بالسفن.
لا يخفى أنّ مثل هذا الحلّ سيزيد من كلفة الغاز على إسبانيا التي تستورد ما لا يقل عن 45 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي عبر الجزائر وهي التي عانت في شهر أكتوبر الأخير من أزمة كبيرة تتعلّق بتسعير الكهرباء الذي يعتمد إنتاجه بشكل كبير على الموارد الغازيّة. أما المغرب فسيواجه ضغطا أكبر في تعويض المصدر الجزائريّ الذي يوفّر نسبة 97 بالمائة من مصادر التموين بالغاز. ولئن قّلل المسؤولون المغاربة عموما من تبعات الخطوة الجزائريّة على اعتبار توجّه المغرب منذ سنة 2011 للاعتماد على الطاقات المتجدّدة -خصوصا الطاقة الشمسيّة- في إنتاج الكهرباء، إلا أن الأسواق الأخرى التي سيتم التوجه إليها للتعويض سترفع من تكلفة السّعر. كما تبقى إمكانيّة التجاء المغرب إلى السوق الطاقيّة الإسرائيليّة كأحد البدائل المطروحة متداولة بشدّة وهو ما سيساهم في رفع منسوب التوتّر في الإقليم. ولا ينبغي كذلك التغاضي عن عنصر آخر في المعادلة الحاليّة، هو التقارب الجزائريّ الروسيّ الذي توطّد بعد القرار الجزائريّ بإعادة النظر في اتفاقيّة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتصعيد الدبلوماسي الجزائري الأخير مع فرنسا.إذ أن أكثر ما يخشاه الغرب حاليّا أن يتّسع الوفاق الجزائريّ الروسي (وهما من كبار المزودين الطاقيين لأوروبا) إلى موضوع الغاز الطبيعي و مراجعة شروط التسعير والتزويد للسوق الأوروبيّة وهو ما قد يدفع بالتبعيّة إلى تأثيرات سلبيّة على اقتصادات دول الإتحاد الأوروبي.
صراع يفسح المجال لقوى دولية
ضمن هذا السياق الإستراتيجي المعقّد الذي تسارعت فيه التطوّرات العسكريّة والسياسيّة، أتت عمليّة بير لحلو التي قُتل فيها ثلاثة أشخاص جزائريّين داخل أراضي الصحراء الغربيّة خلف الساتر الترابيّ الذي بنته المغرب هناك، حيث تصنّف هذه المنطقة على أنها منطقة عازلة ممنوعة على المدنيّين والعسكريين. كان الحدث حافلا بالدلالات، في الزمان، مع اقترانه بذكرى احتفال الجزائر بذكرى اندلاع ثورة التحرير وفي المكان كذلك لرمزيّة منطقة بير لحلو المهمّة لدى جبهة البوليساريو التي أعلنت فيها بيان تأسيس ما يسمّى بـ”الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديمقراطيّة” سنة 1976 .وفي العمق، تستدعي بعض القراءات البعد الثأريّ على اعتبار أن العمليّة كانت بمثابة ردّ مغربيّ على عملية سابقة حدثت في مالي قُتل فيها سائقين مغربيّين يوم 12 سبتمبر الماضي، اتهمت مصادر صحفيّة مغربيّة حينها الجزائر بأنّ لها يدا في هذا الموضوع. كما يحمل استهداف الشاحنة التي كانت في طريقها بين موريتانيا ومنطقة “ورقلة” الجزائريّة كذلك تهديدا غير مسبوق للجانب اللوجستي الذي تسعى الجزائر لاستغلاله في العلاقة مع بلدان جنوب الصحراء أين تسعى لمنافسة النفوذ المغربيّ القويّ هناك.
أشار بيان الرئاسة الجزائريّة الذي توعّد بردّ قويّ إلى استخدام “سلاح متطوّر” في العمليّة، ويبدو أنّ المقصود بذلك الطيران من دون طيّار، هذا السلاح الذي برز مغاربيّا في معارك الغرب الليبي سنتي 2019 و2020 والذي ربّما سيجد طريقه إلى نزاعات أخرى في المنطقة. وتبرز عديد المحطّات السعي المغربيّ الحثيث لامتلاكه خوف تصعيد جديد.
يدفع التوتّر حاليّا بعديد اللاعبين الدوليّين إلى محاولة استغلال ردهات الصراع لتقوية نفوذهم السياسيّ في المنطقة، ومن بينهم أساسا إسرائيل التي وجدت الفرصة سانحة لتعميق اختراقها للمجال المغاربي، حيث وقّعت مع المغرب مذكرّة تفاهم دفاعيّة هي الأولى من نوعها مع بلد عربيّ أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرّباط في 24 نوفمبر الماضي والتي أكّدت الصحافة العبريّة أنها ستسمح بدخول الصادرات الإسرائيليّة الدفاعيّة، فيما أشارت مجلّة “أفريك انتيليجنس” المقرّبة من الدوائر الاستخباراتيّة الفرنسيّة عن سعي مغربيّ وإسرائيليّ مشترك لتطوير مشروع لتصنيع طائرات عسكريّة بدون طيّار في المغرب بالاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيليّة المتطوّرة في هذا المجال، وربّما تكون الاتفاقيّة التي وقّعتها المغرب مع الوكالة الإسرائيليّة للفضاء الإلكتروني في جويلية الماضي هي الإطار القانوني لهذا المشروع.

وسط هذا المشهد، تبدو مهمّة ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربيّة، في طرح مفاوضات “المائدة المستديرة” لجمع الفرقاء المعنيّين بقضيّة النزاع وهم الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو على غاية من الصعوبة رغم الدعم الأمريكيّ الكبير الذي صاحب تعيينه على رأس البعثة. وقد قوبل قرار مجلس الأمن الدولي على تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربيّة لسنة واحدة في 29 أكتوبر الماضي بمعارضة جزائريّة واضحة. أوّل اختبار للبعثة الأمميّة سيكون التحقيق في حادثة بير لحلو لكشف التفاصيل وتحديد المسؤوليّات فمحاولة لمنع تفاقم الأزمة ولكن ستصدم هذه المحاولات حتما بمواقف التصلّب.
في حين تجد العديد من دول الجوار الإقليميّ في موقع الحرج من التوسط في هذه الأزمة، وخاصّة منها تونس التي امتنعت عن التصويت لفائدة قرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو”، وهي الإشارة التي تمّ توصيفها في المغرب على أنها انحراف غير مألوف لتونس عن موقف الحياد الإيجابيّ من الصحراء الغربيّة واقتراب من موقف الجزائر وروسيا من القضيّة. وبرغم الترحيب التونسي اللاحق بقرار مجلس الأمن في محاولة لتجاوز الانتقادات المغربيّة، تظلّ الدبلوماسيّة التونسيّة تتحسّس طريقها بتذبذب في ظلّ الأزمة بسبب تعدّد الرهانات التي يفرضها الوضع القائم حاليّا وانفتاحه على مختلف الاحتمالات.
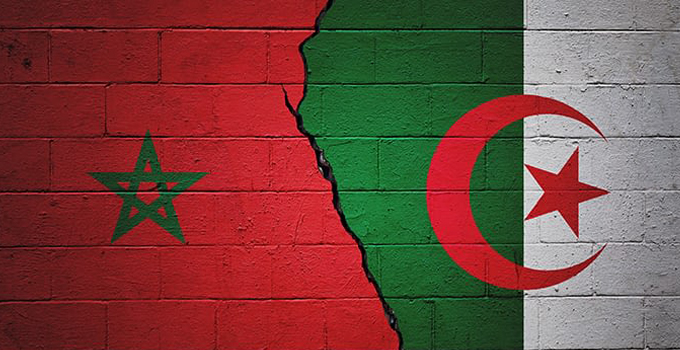




الأخ يتعاون مع العدو لقتل أخيه، يبدو أن الأخ قد حصل على وعد من العدو لتحقيق النصر، ونسي الأخ أن العدو يبقى عدواً ولو بعد ١٠٠ عام، والأخ يبقى أخاً سواء شاؤوا أم لا، فلنتذكر كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع وما فيه من العبر التي تؤكد بأن العدو يسعى إلى اتباع قاعدة فرّق تسد، وهذا ما حصل عند قيام دولة إسرائيل وسط الدول العربية لجعلها مفككة .
انتهى
لقدأدخل الجزائريين أعني النظام أنفسهم في ورطة فالمنطقة التي أستهدت فيها الشاحنات ولو من طرف المغرب هي منطقة حرب وخار الطريق الذي يربط الجزاىر بموريتانيا والتذكير فجبهة أل فجبهة البوليساريو والخليفة للجزائر أعلنت منذ مدة هذه المنطقة منطقة حرب….ترى كيف تواجد أصحاب الشاحنات بهذه المنطقة وبكامل إرادتهم حيث أورد البيان الجزائري أن أصحاب الشاحنات أخذوا إستراحة بالتراضي الصحراوية علما بأن الطريق بين موريتانيا والجزائر لايمر بأراد صحراوية والمنطقة التي أستهدفت فيها الشاحنات تبعد 40 كيلومتر من الطريق بين الجزائريين وموريتانيا إذن من المسؤول عن تواجد الشاحنات بمنطقة حرب؟ وهل كانت تحمل ذخيرة للبوليساريو كمايقال!!!!!؟