“إذا طردتَ غدا –معاذ الله- من الكرسي الذي أنت جالس عليه, يا ليتك كنتَ على الأقل تُحسن الغناء, أو كنتَ مطرانا أو ملاحا. ولكنك لستَ إلاّ جنرالا, فأنت إذا لا تصلح إلاّ لإعطاء الأوامر. أقبرْ في مكان مضمون المال المتبقّي لديك من الحكومة -هكذا نَصَحتْه أمّهُ- في مكان لا يمكن لأحد الوصول إليه (وضع يده عليه), حتّى إذا ما أُجبرْتَ على الفرار كهؤلاء الرؤساء المساكين الّذين لم تعد لهم أوطان فباتوا يجترّون النّسيان ويتسوّلون وداع البواخر هناك في بيت على الجرف. قالت له: “تأمّل نفسك في مرآتهم”, ولكنّه لم يكن يأبه لها وبصيغة سحرية كانت تلجم اضطرابه الداخلي أجابها: لا تشغلي بالك يا أمي, هؤلاء الناس يحبونني”.
غبريال غرسيا مركاز, خريف القائد العجوز, 1975.
[1]
كان لا بدّ له إذا, من الرّكون إلى شيء آخر, يحمي به نفسه على سدّة الحكم, لبضعة عقود.. شيء آخر يشبه القتلة المحترفين, الّلذين يقدّمون الخدمات المتنوّعة لمن يدفع الثّمن, ممن تعجّ بهم الشاشات الهوليوديّة, ولكن هذه المرّة في شكل إنتاج ضخم… في ظرف وجيز, بضعة سنين, صار عدد المنتسبين إلى أجهزة “الأمن” المختلفة, 140 ألف من الرّجال.. ومن النّساء كذلك.. -إحدى المكاسب العظمى في تونس, تحرير المرأة!- هذا بالإضافة إلى “لجان الأحياء”… لقد كان لإقامة بن علي في بعض دول أروبا الشرقيّة, خلال الثّمانينات, فوائد جمّة!
النّتيجة الثّالثة لإنتخابات سنة 1989, هي إطّلاع مؤسّس “العهد الجديد” على حقيقة الإمتداد الشّعبي للتيّار الإسلامي, الذي شارك في هذه الإستشارة, وهو المحروم من الشّرعيّة القانونيّة, بطريقة غير مباشرة, فساند قوائم مستقلّة أحرزت على نسب عالية من الأصوات, حتّى بعد عمليّات التّزوير للنّتائج. فإن كان هناك خطر ما على مستقبل بن علي ونظامه فسيكون مأتاه من الإسلاميّين, الّذين سرعان ما أستعادوا أنفاسهم برغم الضربات والرّجات المتتالية, لا سيّما الأخيرة منها. إنّ بن علي هو الأدرى -وهومهندس هذه الرّجات- بمقدارها على ميزان ريختر…
فما العمل على ضوء هذه الإستنتاجات؟
أوّلا: إستقطب بن علي, في عمليّة تأميم كبرى, وبدون عوائق تذكر, أعدادا لا يسهان بها -وإن قبل المعنيّون بالأمركلّ أشكال الهوان- من المعارضين (سابقا) اليسارييّن والليبيراليين, فرادى وجماعات, إلى نظامه… فجاؤوه مهرولين من كلّ فجّ عميق… ويروي الثّقات أنّ المدعو محمّد الشّرْفي, وكان آنذك رئيسا لرابطة حقوق الإنسان, حينما علم بنبىء استدعائه إلى قصر قرطاج, لغرض تعيينه وزيرا للتّربية القوميّة, راح راكضا لا يلوي على شيىء, غير آبه لبقيّة أعضاء المكتب التّنفيذي للرّابطة, الذين كانوا بصدد انتظاره لترؤّس جلسة عمل, فلم يكلّف نفسه حتّى الإعتذار هاتفيّا… ومن الغد علم أعضاء مكتب الرّابطة سبب الغياب من خلال الجرائد.
“… قرر أن يكون هذا آخر تعذيب يمارسه نظامه, فقُتلت التماسيح, وفككت غرف التعذيب, حيث كان من الممكن هرس كل العظام الواحد تلو الآخر بدون قتل الضحيّة, وأعلن العفو العام, وشرع في تهيئة المستقبل بفضل فكرة سحرية: كل مشاكل هذا البلد متأتية من أن النّاس لهم الكثير من الوقت للتفكير, فوقع البحث عمّا يمكن أن يشغلهم. رُدّ الاعتبار إلى ألعاب شهر مارس للزّهور, وكذلك للمسابقات السنويّة لملكات الجمال. وأُسّس أكبر ملعب لكرة القدم في منطقة الكراييب, وأُجبر فريقنا على تحقيق الشعار التالي: الانتصار أو الموت. وأعطيت الأوامر لتأسيس مدرسة مجانيّة للكنس في كلّ ولاية, دأب طلبتها, وقد حمّستهم التشجيعات الرئاسيّة, على كنس الشوارع بعد أن فرغوا من كنس البيوت, وبعد ذلك الطرق الفرعيّة والأزقّة, بحيث باتت أكداس القمامة تسحب وتنقل من ولاية إلى أخرى من دون أن يعرف أحد كيف يمكن التخلص منها. كانت هذه العمليّة تتمّ في شكل مواكب رسميّة ترفرف فوقها أعلام الوطن ولافتات كبرى: الله يحفظ أنقى الخلق, هذا الذي يسهر على نظافة الأمّة. في حين كان هذا الفظّ المنغمس في التّفكير يجر رجليه البطيئتين, باحثا عن أساليب جديدة لإلهاء السكان المدنيين, كان يشق طريقا بين المجذومين والعميان والمشلولين الذين يتضرّعون عنده حتى يناولهم ملح العافية, مباركا باسمه في نافورة الباحة أولاد محمييّه وسط المتزلّفين الفاقدين للحياء والّذين أعلنوه أوحد… ” [2]
وكانت السّهرات التّلفزيونّة التّرفيهيّة اللاّمتناهية, الّتي تتخلّلها عروض الأزياء, والرّقص “الكوريغرافي” لتلامذة مدرسة سهام بلخوجة -المتعاقدة أبديّا مع مؤسسة الإذاعة والتّلفزة التّونسيّة- الذين يقدّمون نفس الرّقاصات بكلّ مهنيّة وبكلّ روتينيّة؛ فتراهم وراء الشّاب خالد, ووراء فاطمة بوساحة, ووراء حبوبة, ووراء لطفي بوزيّان, ووراء قاسم كافي؛ وتراهم أيضا إلى جانب هالة الرّكبي , وإلى جانب لطفي البحري, نجمتين من نجوم تقديم البرامج الإستعراضيّة الكبرى, وبوقَين من أبواق “تونس العهد الجديد”..و”تونس بن علي”… كما يحلو لهما نعت خضرائنا…
تلك إذا “ثقافة العهد الجديد”, الّتي يمكن تلخيص “فلسفتها” في مقولتيْ : “إبتسم إنّها تونس” و”تونس تمرح وتزهو”! ومن مزايا هذه الثّقافة-المركيتينق, أنّها كانت دوما ساعية إلى ترويج وبيع صورة تونس اليوم: بلد آمن تغمره السّعادة والفرحة والهدوء… بلد انقشعت من سماءه كلّ الغيوم, ومن شوارعه وأزقّته ومصانعه وإداراته ومدارسه كلّ خرقة من قماش تدعى حجاب وازدهرت فيه تجارة موس الحلاقة… مشهد جميل وجدّ مطمئن, مقارنة بما كان يجري في محيط تونس القريب والبعيد: الجزائر, ليبيا, يوغسلافيا سابقا, الشرق الأوسط… والهدف من ترويج هذه الصّورة, جلب السيّاح ورؤوس الأموال الأجنبيّة, البيضاء منها والمرشّحة إلى التّبييض!… ويسمّى هذا عولمة !
ولو شاهدت -أو غصبت نفسك على مشاهدة- إحدى إنتاجات العهد الجديد الثّقافيّة, لأستنتجت أنّ”فلسفتها” تقوم على الإدراج القصري لثنائيّة الأصالة والتّفتّح في كلّ صغيرة وكبيرة… في محلّ -وغالبا- في غير محلّ. فمثلا “نوبه” و”حضره” -مشهدان ضخمان- لعب فيهما رجل المسرح الجديد [3] الفاضل الجزيري دور “المايسترو” قائد الفرقة السّنفونيّة (أتخيّل هنا قرامشي, صاحب نظريّة المثقّف الكامل -أو العضوي- يتقلّب في قبره لما آلت إليه نظريّته) وهو الذي لا يجيد قراءة سلّم موسيقي على مفتاح الصّول, يسيّر, كمن “يعصّد”, خلطة عجيبة وغير متجانسة -فضلا عن أن تكون متناغمة- من الأصوات ومن الآلات الموسيقيّة : مِزْوِد, كمان, طبلة, بيانو, زُكرة, قيثارة كهربائيّة, دربوكة… وطبعا بِنْدير! أضف إلى هذا خليط أعجب, من الأصوات : إسماعيل الحطّاب, لطفي بوشناق, صلاح مصباح, الهادي الدّنيا, وفاطمة بن عيّاد (صوتا وجسدا)… إنّها عمليّة توليد قصريّة لجنين هجين (hybride), تحت تهاليل وزغاريد زادتها نشوة وهيجانا بعض جرع من “السلتيا” و شطحات صوفيّة واضحة التّمويه لشباب مصفوفي الشّعر تحت وطأة “القومينه” ولشاباّت -لا أنكر جمالهنّ- : تلامذة مدرسة سهام بلخوجة.. طبعا! الكلّ -في ما عدى المايسترو- في زيّ تقليدي أصيل.
النّتيجة : مهرجان للرداءة الوطنيّة (un festival du mauvais goût) إمتدّ لعقد ونصف.. ولا يزال.
لقد كانت خطّة آستئصال الظّاهرة الإسلاميّة محكمة ومتقنة… وكان تطبيقها على أرض الواقع أكثر إتقانا. فكيف كانت ردّة فعل الإسلامييّن تجاه هذا المخطّط الذي كان يستهدف وجودهم ومن ورائه وجود أيّ نوع من أنواع الوعي الجمعي, لاسيّما وقد علمت حركة النّهضة به وبتفاصيله مسبقا؟
لا شيء…
لقد أسلمت الحركة الإسلاميّة أمرها للّه في أضخم عمليّة “تواكل” وسمّته “توكّل”. ووقفت موقف المنتظر للعاصفة حتّى تمرّ, حاسبة أنّ ما كان يحدث لها “مجرّد” محنة وأبتلاء من الله “وبشِّرِ الصَّابِرِين…”. نعم لقد إتُّخِذَتْ بعض الإجراءات الإحترازيّة فغادر عدد من القيادات وعائلاتهم البلاد نحو بعض المنافي العربيّة والغربيّة. فإحدى كبرى المبادئ الإستراتيجيّة للحركة الإسلاميّة في تونس, ممّا وصفته ب”الخطوط الحمراء” الّتي لا يمكن الحياد عنها هي الحفاظ على سلامة قيادتها. أمّا القواعد العريضة لهذه الحركة فقد تُركَت لأمرها “لتواجه” مصيرها المحتوم ؛ فكانت الملاحقات وكانت المداهمات وكانت الإعتقالات وكان التّعذيب وكان التّقتيل وكان التّشريد وكان اليتم وكان تخريب البيوت وكان الحرمان من الشّغل وكان التّعريف بلإمضاء في مراكز الشّرطة في الصّباح وفي المساء لمن أنهى فترة عقوبته…
ما نسينا أنتَ قد علّمتَنا
* * * * *
بسمة المؤمن في وجه الرّدى
ستظَلُّ في الحنايا علما
* * * * *
يُهتَدى به على طول المدى
مأساة الحركة الإسلاميّة أنّها حملت فكرة -لا بل حلما- لم يتحمّل وعيها -أو بالأحرى لا وعيها- التّاريخي ثقلها, فكان أن ضيّقت آفاقها واختزلتها ضمن الأطر المفروضة عليها من قِبل من جاءت أصلا لمقاومتهم ولإسبدال مقولاتهم المابعد-حداثيّة post-modernes. لقد رفعت الحركة الإسلاميّة شعار محاربة النموذج الحضاري الغربي, المستعبد للإنسان, أو بالأحرى تجاوزه إلى نموذج حضاري إسلامي يعيد الإنسانيّة لهذا الإنسان بتحريره من قيود المادّة ومن جاذبيّة الأرض ومن تسلّط العباد, لتسمو به إلى ما خُلق من أجله : “عبادة ربّ العباد”, لعلّه يحقِّق على هذه البسيطة -الفانية حتما- بعض عدل وبعض حريّة وبعض كرامة يشعر في ظلالها الإنسان بالسّعادة أو بما يقاربها ؛ بدون اشتراط أعتناق الإسلام للتّمتّع بذلك, وهذا ما يشهد عليه نصّ القرآن وكذلك التّجربة المحمّديّة, إذ أنّ أعتناق الإسلام هدفه استئناف تلك السّعادة بعد الممات, وهذا داخل في باب الإيمان… والإيمان كما هو معلوم من الدّين بالضّرورة, أمر إختياري, بل هو قطب الرّحى, وأعلى مراتب ممارسة الحرّيّة, هذه النّعمة الإلاهيّة المرتبطة شديد الإرتباط بنعمة العقل “ولقد حمّلنا… فحملها الإنسان”…
لقد فهم سيّد قطب رحمه الله, ربّما لشدّة قربه من الكلمة le verbe -فلقد كان, وبقي إلى آخر رمق في حياته, أديبا وشاعرا ومفكّرا حرّا قبل أن يكون منظّرا لجماعة الإخوان المسلمين- وقلّة من أمثاله, هذا المعنى العظيم, فدفع ثمن هذا الفهم باهضا, حياته.من أعدم قطب في نهاية الأمر؟ حكّاما صغارا… ملوكا بلا تيجان, ولكن في أزياء عساكر لا تتّسع صدريّاتها لكلّ النّياشين القصديريّة التّي لم تجنى في ساحات معارك الذّود عن الوطن, بل على المنصّات الخطابيّة وسلالم التّرقيات الإداريّة المشبوهة إستخرج هؤلاء نظريّاتهم من سائل بالوعات متعفَّن, هو خليط من القوميّة في شكلها الأوروفاشستي version euro-fasciste, ومن الإشتراكيّة في شكلها الشرق أوروبي version Europe de l’Est, والثّانية لا تقلّ فاشية عن الأولى, وزادوها مسحة من عروبة داحس والغبراء, بعد أن أسقطوا منها النّبل والشّهامة والشّرف. ولمن لا يزال يخامره شكّ في هذا الأمر, فليبحث في دليل الهاتف لبلديّة لاهاي عن عنوان ميلوزيفيتش, صلوبودان… سيشرح له الأمر بأكثر تفصيلا.
نظريّة سيّد قطب حول “الجاهليّة المعاصرة” أو “جاهليّة القرن العشرين”, وحول وجوب إرجاع “الحاكميّة لله”, هي ثمرة أربعين سنة من القراءة والتأمّل لا للترّاث العربي الإسلامي فحسب بل للمخزون الفكري الغربي بتيّاراته… صاغ سيّد أفكاره في ظرف وجيز نسبيّا – عقد ونصف تقريبا – قضّى معظمه في سجون عبد النّاصر, لينتهي به المطاف إلى حبل المشنقة, في يوم مظلم من أيّام أغسطس 1966. يومها كتب للزّعامة العربيّة هزيمة 67, وما تبعها ويتبعها إلى اليوم من هزائم. أقزام الفكر وصغار النّفوس من أتباع اليسار والقوميّة موديل الصحاري السّاخنة, ممن قرأوا بضعة كتب في ترجمة رديئة للفكر الماركسي اللّينيني, سارعت إلى تصنيف قطب ضمن قائمة منظّري الرّجعيّة, الدّاعين إلى إقامة ثيوقراطيّة يسودها النّظام الأخلاقويّ l’ordre moral , والإقطاعيّة, مع إضافة لازمة لمسألة المرأة وما ينتظرها من غُبن وقمع ومنع من إبداء مفاتنها بالبيكيني على رمال شواطئنا الجميلة. لم يفهموا شيئا من قطب المفكّر. هل قرأوه حتّى؟ ناهيك عن سيّد الأديب. اليوم, وبعد خمسة وثلاثون عاما من إعدام هذا الرّجل, ترى هؤلاء وقد خضعوا لكلّ المتمورفوزات métamorphoses الممكنة, فتحوّلوا, كما تتحوّل الضفادع, من أقصى اليسار المتمرّد إلى برجوازية باهتة الألوان – روبا فيكيا – ولكن في ثبات على هستريتهم… تراهم يعجبون أنّ فكر الشّهيد لا يزال يستقطب أجيالا بأسرها, فيطالبون بمنع هذه الأفكار وبإعدامها هي الأخرى.
الكلّ يقرّ اليوم بأنّ خطّة بن علي قد نجحت في تحقيق أهدافها. وصلت إلى ما كانت تصبو إليه, وأكثر؛ فصيرورة التّفكّك والانهيار كانت أسرع وأسهل من المتوقّع, وأنّ عموم الجسم لم يحرّك أدنى مضادّات حيويّة… وأنّ صرخات الألم والموت المنبعثة من حناجر آلاف المساجين كانت مكتومة بأسوار برج الرّومي وجدران كلّ الأبراج المشابهة له… فصارت هذه الصرخات كالّتي تحاول حناجرنا إطلاقها أثناء كوابيسنا اللّيليّة… بلا جدوى.
في وحشة هذا الكابوس العام, المظلمة, كان لا بدّ لبعض الشّموع أن تضيء. شعلة, فإثنان, فثلاثة, فأربعة, ربّما أكثر من ذلك… استمرّت في الوميض بوعي تامّ منها بأنّ في وميضها يكمن موتها, بالذّوبان. ويسمّى هذا “تضحية” في آخر قاموس أحرقناه. لا أملك إلاّ أحني هامتي احتراما, لرجال أذكر منهم هشام جعيّط, محمّد الطّالبي, منصف المرزوقي, توفيق بن بريك… للوهلة الأولى لا شيء يجمع بين هؤلاء… لا سيّما الإيديولوجيا, ولكن ما جدوى الأفكار والإيديولوجيّات أمام القيم؟ إنّها – أي الإيديولوجيّات والأفكار – مجرّد طلاء برّاق vernis لا يمكن بأيّة حال أن يحجب عن أعيننا معدن الرّجال… فهذا هو الأهمّ, في نهاية الأمر. الرّْجُولِيَّهْ: كلمة تتداولها العامّة, وتجهلها النّخبة. جعيّط, بكبريائه المبني على عمق علمه بالتّاريخ, رفض الإنصياع للرّداءة العامّة. الطّالبي, ومؤرّخ ومفكّر مؤمن, أصرّ أن لا يلقى الله وفي كتابه صمت ورضاء بالظّلم. المرزوقي, طبيب وكاتب آمن بقدسيّة حقوق الإنسان وكرامته, ولم يتزحزح عن هذا الإيمان قيد أنملة, ولو فعل لحكم على نفسه بالخيانة… خيانة أبقراط – non assistance à personne en danger . بن بريك, شاعر قبل كلّ شيء, وصحفي حين يغيب عنه شيطان الشّعر, وهو قبل وبعد ذلك عاشق لصوت ماريّا كلاس, ولذلك فإنّه انفجر ذات يوم. أمر يكاد يكون أكيد, كلّ هؤلاء قرأوا ذات يوم من أيّام الصِّبا قول المتنبّي, فسكنهم: عشْ عزيزا أو متْ وأنتَ كريم…
قد تختبئ نخبنا السّياسيّة المترهّلة, وهي “ترسم” معالم المستقبل, وراء حجّة – في نهاية الأمر جدّ واهية – وهي “مراعاة الخصوصيّات التّونسيّة” (“شعب مسالم وهادئ”, و”نخشى الهزّات”, و”نوصل السّارق إلى باب داره”, الخ). وهذه في حدّ ذاتها مقولة حقّ أريد بها باطل! من الطبيعيّ أن نراعي خصائص المجتمعات, ولكن من الواجب أيضا الأخذ بالقوانين والسّنن التّاريخيّة والكونيّة… فلو تأمّلنا في البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع التّونسي اليوم, لوجدناه في تشابه كبير مع عدد من بلدان أمريكا اللاّتينيّة في فترة ما بين الخمسينات والثّمانينات: جنرال حاكم؛ نظام بوليسي؛ أوليغارشيا مكوَّنة من بضعة عائلات, تربطها أواصر الزّواج والقرابة, تتقاسم فيما بينها كلّ القطاعات الاقتصادية المربحة, وتتصرّف في الكواليس كمنظمّة مافياويّة؛ معارضة كرتونيّة, تقوم على أحسن وجه بمهمّة “النّقد البنّاء” وتقديس وحماية “قيم” ما بعد الحداثة كآخر كهف نياندرتالي قبيل الانقراض… وتبرّر في سبيل ذلك استبداد السّلطة وتسمِّيه “هيبة الدولة”؛ و”ثقافة” مدعومة تسعى إلى إفراغ المجتمع من كلّ محتوى وملإه… بالفراغ, بات القائمون عليها, رغم “طلائعيّتهم” و”تقدّميّتهم” و”ثوريّتهم” مجرّد أدوات تلميع أحذية… أحذية الجنرلات, وبات “الشّاعر” – كالمومس في أحضان الفتوّات – مُجرّد مقدّم برامج تلفزيونيّة.
ما العمل الآن؟
ما العمل ونحن على مشارف “انتخابات” رئاسيّة “جديدة” [4] ستكرّس إلى أجل غير معلوم “مبدأ” الرّئاسة مدى الحياة بفضل التّنقيحات الدستوريّة, وكأنّ لهذه الكلمة – الدّستور – معنى يذكر؟
ما العمل وقد باتت تونس فريسةً لكلّ كلاب البراري و لجياع بني آوى, تتناهش ثرواتها في أضخم عمليّة نهب في تاريخ هذا البلد… حتّى زحف بني هلال, مقارنة بما يجري الآن, هو بمثابة عمليّة إعمار؟
وحتّى لا نستفيق يوم, وقد انتصب على جثّة وطننا حامد كرزايٍ ما, أو مجلس حكم انتقالي… تصوّروا ولو للحظة, مجلس حكم انتقالي يتكوّن من “زعيم المعارضة التّونسيّة”, محمّد الشّرفي – كما لقّبته الإنتليجنتسيا الباريسيّة على صفحات جريدة لوموند- ومن “ناشط حقوق الإنسان”, خميِّسْ الشّمّاري, هذا الّذي رأى ذات يوم – وربّما كلّ يوم- أنّ حقوق الإنسان تتوقّف عند حدود الإسلامييّن… فهؤلاء لم يُحسمْ بعد فيما إذا كانوا فعلا منفصيلةالإنسانأملا…ومنإحدىكلونات clones خالدة مسعودي, تلك “المرأة المنتصبة” une femme debout – والتّعبير, طبعا, للأنتلجنتسيا الباريسيّة – ولا أحسب أنّها تطمع في وضع غير هذا! إحدى اللّواتي يعتبرنا أنّ تحرير المرأة لا يتمّ إلاّ بتكبيل مجتمع بأسره, وبإدخال القضبان الحديديّة وقوارير الكوكاكولا والمرناق [5] بعد احتسائها, في أدبار الرّجال… هناك في مكاتب وزارة الدّاخليّة: شريط بَازْمُوَا Baise moi يُصبح عندنا حقيقة واقعة لا مجرّد خيالة fantasme إحدى غلاة الحركة النّسويّة في باريس… تصوّروا أيضا, في مجلسنا الانتقالي, واحد من أشباه كرادجيتش الجزائر- سعيد سعدي – الّذي طالما “نظّر” من فوق مقعده الوثير في برلمان ما كان يحلم بالوصول حتّى إلى أسواره الخارجيّة لو دخل في عمليّة انتخابيّة شفّافة, لمشاريع الإبادة الجماعيّة لشعب لا يحسن الاختيار…
ما العمل الآن؟
ما العمل وكلّ المؤشّرات تدلّ على أنّنا نسير قدما في هذا الاتجاه؟ ولكن ما قيمة “المؤشّرات” أمام عزم الرّجال؟ لا بدّ لكلّ راغب في تحمّل مسؤوليّته التّاريخيّة أمام الله وأمام النّاس أن يعي بأنّ الأمر خطير… إنّها مسألة حياة وطن أو موته. فوالله, ما لم نعي هذا الأمر فسنخرج نهائيّا من التّاريخ…
وحتّى نبقى تحت الشّمس, في دائرة التّاريخ, لا بدّ لنا من التخلّص نهائيّا من “التّنظيرات الإصلاحيّة”, فهي جبن… جبن… جبن… لا بدّ لنا من ثورة… نعم أقولها بلا عقد. لماذا تحقّق كلّ الشّعوب ثوراتها لتنهض, ونرضى نحن بالهوان… لماذا نُحرم من حلاوة صنع التّاريخ.
وحتّى لا أُفهَم خطأً, فأُرمَى بالطوباويّة, أقول بأنّ كلمة ثورة لا تعني حتما العنف؛ كما الجهاد لا يعني قسرا القتال. وهل يوجد عنف يصل إلى ما بلغه عنف السّلطة في بلداننا. إنّها مسألة محتويات ومناهج. إنّ كتابة كلمات على الجدران ليلا, عملا ثوريّا؛ وكذلك وضع منشور في صندوق بريد, عملا ثوريّا؛ والتّرنّم بنشيد ممنوع, عملا ثوريّا؛ وكتابة قصيد, عملا ثوريّا؛ والتّظاهر في الشّوارع والإضراب عن العمل أو عن الدّراسة أعمالا ثوريّة؛ ومعاقبة مجرم سفّاح يتلذّذ بتعذيب الأبرياء, عملا ثوريّا… كلّ تلك الأعمال بتواترها وتصاعدها تمثّل خطرا وهاجسا يقضّ مضاجع سلطة الاستبداد, ويدفع بها إلى الارتباك… والارتباك هذا هو بداية نهاية الطّغاة… ولا أظنّ شعب تونس بعاجز عن مثل هذا الأمر وهو الذّي قدّم الأمثلة على ذلك عبر تاريخه القريب والبعيد. ألم نكبر ونحن نردّد بدون هوادة أبيات شاعرنا العظيم:
* * * * *
فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بدّ للّيل أن ينجلي
* * * * *
ولا بدّ للقيد أن ينكسر
[1] Gabriel Garcia Marquez, L’Automne du patriarche, 1975.
[2] المصدر السابق
[3] لقد عاش المسرح التّونسي طفرة نوعيّة بين منتصف السّبعينات ومنتصف الثّمانينات, فأفرز إنتاجات مجدّدة في أشكالها وكذلك في مضامينها؛ أذكر منها مسرحيّة غسّالة النّوادر للمسرح الجديد, “تمثيل كلام” لمسرح فو ومسرحيّات أخرى لمجموعة المسرح العضوي… شكّلت هذه الأعمال قطيعة مع ما سبقها من الإنتاج المسرحي “الكلاسيكي” والّذي لا يقل عنها نجاحا كأعمال فرقة الكاف وفرقة المغرب العربي للتّمثيل -“أهل الهوى”, “الكرّيطة”, “القافزون”-, فرقة قفصة -“عمّار بوزورّ”, “أبو القاسم الشّابي”, “صلاح الدّين”- كلّ هذه الإبداعات أتى عليها حريق العهد الجديد “وَهُمْ نَائِمون فَأَضْحَتْ كَالصَّرِيم”
[4] نُقّح الدستور بالفعل, وجرت الإنتخابات كما أريد لها, وخلف الر يس نفسه إلى أجل غير مسمّى. وعادت حليمة إلى عادتها القديمة.
[5] نوع من أنواع الخمور المشهورة في تونس, ويحمل اسم إحدى المناطق الخصبة بالضّاحية الجنوبيّة للعاصمة.

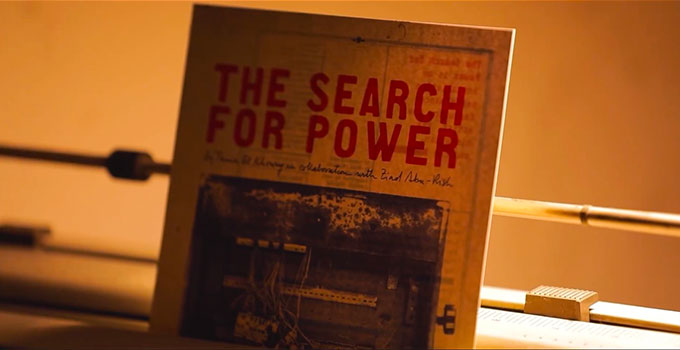
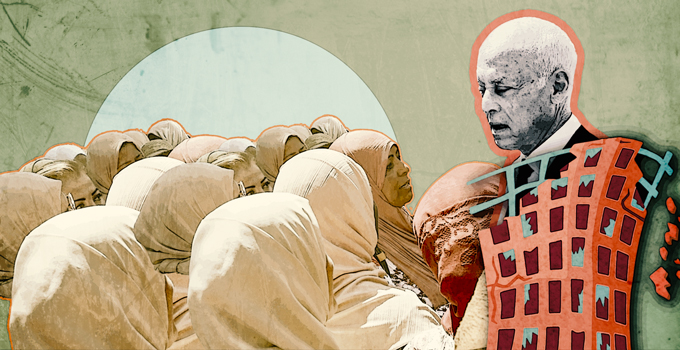

iThere are no comments
Add yours